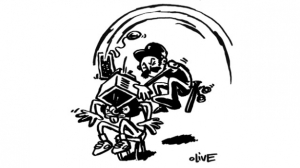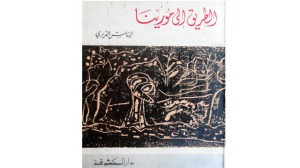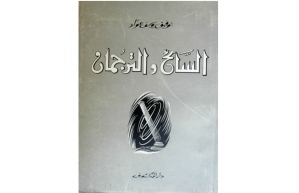أعد الملف وكتبه محمد أبي سمرا
ملحق جريدة النهار في 01-12-12

لم أعثر على نسخ ورقية من أعداد “المكشوف” الاسبوعية اللبنانية التي كانت تصدر في بيروت ما بين 1935 و1949، واشتهرت كجريدة أدبية رائدة لمؤسسها وصاحبها فؤاد حبيش (1904 – 1973) بصفته “رئيس التحرير المسؤول”، الى جانب التعريف بها “جريدة أدب وفن وسياسة”، على ما يتصدر غلف أعدادها كلها التي أمضيت بضعة نهارات أتصفح الكثير منها على شاشة “ميكروفيلم” في مكتبة الجامعة الاميركية في بيروت.
من دون خطة مسبقة وبلا نظام، دوّنت أثناء تصفحي وقراءتي المتقطعة، طائفة مشتتة من عناوين أبواب ومقالات ومقتطفات منها، وأسماء كتاب وشعراء وصحافيين، وملاحظات وتعليقات وخواطر. هي رغبة تقصي تراث الصحافة والحركة الأدبية، لغةً وموضوعاتٍ وأعلاماً، ما قادني الى “المكشوف” التي لم أكن أعلم عنها سوى أنها كانت رائدة في صناعة الصحافة الأدبية في لبنان طوال 15 سنة. ألوف من الصفحات والمقالات، مئات من الاسماء والعناوين، تواترت تباعاً وسريعاً أمام ناظريّ على شاشة جهاز “الميكروفيلم”، فأصابني ما يشبه الدوار والضياع. بعض الصفحات والموضوعات والاسماء مرّ بصري سريعاً عليها، وبعضها الآخر استوقفني مطوّلاً، فقرأت هذا المقال أو ذاك، ودوّنت ملاحظاتي آملاً في استعمالها للتعريف بالمجلة القديمة. لكنني في الحالتين، غرقت هائماً مأخوذاً بتلك اللذة الغريبة أثناء رحلتي على بساط ريح، نسيجه الكلمات والاسماء المنبثقة من فجوة في الزمن، والمنداحة سريعاً أو بطيئاً أمام عينيّ، مبعثرة كقطع بازل طالعة من ذلك الماضي البعيد الآفل والمنقطع، الذي تبعث محاولة تأليف صوره وعناوينه واتجاهاته، وتأويلها، ضرباً من المتعة المعذّبة تشبه اختبار توليد زمن وحوادث وشخصيات وسياقات روائية. هذه الحال لازمت قراءتي مدوّنات الرحلة بعد الفراغ منها، للعثور على خيوط تمكنني من تنظيم قطع البازل المتناثرة التي جمعتها من المتاهة، علّها تفضي الى رواية استقصائية وصفية لملامح جزئية من تاريخ حقبة من الحياة الصحافية والأدبية المنصرمة في لبنان.

التاريخ المجهض
في البداية لا بد من ملاحظة أولى يخلص اليها متصفح الدوريات القديمة كـ”المكشوف” وسواها: تقنيات التوثيق والأرشفة، وجمع المطبوعات والكتب وتنظيمها وتبويبها واستعمالها في مكتبات الجامعات غير الحكومية، متقدمة بأشواط على برامج التدريس والبحث وأساليبهما في مجالات العلوم الانسانية في هذه الجامعات. أما استبعاد الجامعة اللبنانية من هذه المقارنة، فهو من تحصيل الحاصل، ولا يبعث على غير التذكير بالحال الزرية التي انحدرت اليها هذه الجامعة منذ بدايات الحرب (1975 – 1990). والحال هذه تطاول أساليب التدريس والبحث والادارة واختيار المدرّسين، وتبلغ ذروتها في مجالات التوثيق والأرشفة وجمع الكتب والمطبوعات وتنظيم المكتبات التي أُهملت محتوياتها وبليت وغزاها التلف والغبار من دون أن تُستعمل في حال توافرها في كليات الجامعة اللبنانية وفروعها المتناسلة.
“المكشوف” التي صانتها تقنيات “الميكروفيلم” في مكتبة الجامعة الاميركية، بليت صفحاتها الورقية واهترأت، من دون أن تحظى بدراسة تعرّف بها وتضعها في سياق لا يزال مفقوداً للحياة الصحافية والثقافية التي لم يؤرخ بعد لأشكالها الكتابية وموضوعاتها وأعلامها. أما مشروع إعادة طباعة منتخبات من أعداد “المكشوف”، فقد أجهض قبل حوالى 10 سنين من دون أن يبصر النور، فذهب سدىً، جهد الاختيار والتبويب والطباعة الأولية الذي أنجزه الشاعر أنسي الحاج، ومات المشروع جنيناً من دون أن يرثيه أحد، في وقت درج صحافيون وكتّاب وشعراء على رثاء مظاهر الحياة الثقافية وأماكنها الراحلة، ولاسيما المقاهي التي أُقفلت في شارع الحمراء. جاءت تلك المراثي شبيهة بالبكاء على الاطلال في إطار ما يعتبره كثيرون أفول حقبة ثقافية بيروتية ولبنانية زاهية، هي ستينات القرن العشرين والنصف الاول من سبعيناته التي رُفعت أعلامها ورفعت نشاطاتها وأماكنها أنصاباً للحنين والتبجيل، بدل التأريخ لها ولهم ولأدوارهم. لذا ظلت الصحافة والحركات الأدبية وتياراتها وأنواع الفنون المختلفة، بلا تأريخ كُتبت منه شذرات ضئيلة مشتتة.
هذا ما يجعل تصفح “المكشوف” وتدوين ملاحظات وانطباعات وخواطر حول مادتها، محاولة لا تتجاوز وضع إشارات وعلامات متباعدة مختنقة الضوء في ضباب تاريخ غائب وفي محاق عتمته. فالحساسية التاريخية ضعيفة في ثقافتنا العربية التي غالباً ما تعوّض عن ذلك الضعف بالإنشاء الخطابي واللفظي الممتلئ بفراغ اللغة من مادتها الحيّة ومن الوقائع المتدافعة، بدل أن تنجبل الكتابة ولغاتها بمادة العيش والعالم المولّدة للروايات التاريخية.

المنشّط الثقافي: فاعلية الحضور الخفي
لم تُكتب لمؤسس “المكشوف”، فؤاد حبيش، ولا لسواه من المؤسسين في الحياة الثقافية اللبنانية المعاصرة، من أمثال ميشال أسمر (1914 – 1985)، مؤسس “الندوة اللبنانية” (1946 – 1975)، سير تأريخية. فالرجلان يتميزان ويتشابهان في أن حضورهما الفاعل في الحركة الصحافية والأدبية والفكرية، اختفى خلف نشاط المؤسسة التي أنشأها كلٌّ منهما، والتصق بها اسمه وحضوره حتى الذوبان والامحاء. والحق أن هذا النوع من الحضور – الاختفاء، أو الحضور الخفي، يختلف عن حضور الاعلام – النجوم في أن كلاً منهما لم تصدر شهرته عن إنتاجه الشخصي في مجال الصحافة والأدب والثقافة، بل عن فاعلية مؤسسته، وجدَّتها وريادتها، بعد مبادرته الشخصية الى إنشائها وإدارتها بنفسه. قوة حضور مؤسستيهما وتأثيرهما في المجال العام، أديا في حالة حبيش وأسمر الى صناعة اسم وشهرة لكلٍّ منهما، مستمَدَّين من جهدهما ونشاطهما في استقطاب طاقات وأسماء أدبية وثقافية بارزة، وفي إنشاء جسور للتفاعل بين هذه الطاقات، وبينها وبين جمهور واسع في الحياة العامة. لقد ذاب الرجلان واختفيا في عمل توليفي وتأطيري مركّب، وحضرا في نسيجه ومفاصله كمحفّزين ومنشّطين، كأنهما جنديان مجهولان ومعلومان في وقت واحد.
مثل كل فكرة جديدة ومبادرة الى تجريبها وتحقيقها، لم يكن مشروع كلٌّ منهما واضح المعالم والأفق في بداياته. تجربتهما في العمل الصحافي والثقافي المزدهر والناشط في ثلاثينات القرن العشرين، كانت دليلهما الى توافر قابليات يمكن جذبها الى مشروع جديد، ما كان له أن يقوم وينطلق إلا بمشاركة وجهود جماعية، شغل الرجلان دورين محوريين فيها، وكان استقطابها في أصل مشروعيهما وفصليهما. وما إن نجح المشروعان وارتسم لهما أفق في الحياة الصحافية والأدبية والثقافية، حتى انعطفت حياة كلٍّ منهما ونشاطه ومساره ومصيره انعطافاً جديداً حاسماً، أخرجه من الظل والإغفال الى الضوء والعلن في زمنه، وبعد رحيله الى عالم الغيب.
حين يقال “المكشوف” يحضر فوراً اسم فؤاد حبيش قبل كل اسم آخر من المساهمين في صناعة شهرتها بعد استقطابها نخبة واسعة من الكتاب والشعراء والصحافيين أمثال الياس أبو شبكة ورئيف خوري وعمر فاخوري ومارون عبود وسعيد عقل وتوفيق يوسف عواد وخليل تقي الدين وفؤاد أفرام البستاني وسواه من البساتنة، وكامل مروة ولويس الحاج وفؤاد حداد (أبو الحن). هؤلاء وغيرهم كثر، كان لهم حضورهم الدائم والمتقطع في “المكشوف”، وساهموا في نهضتها كما ساهمت هي في شهرتهم طوال 15 سنة. ولا يمكن أن يقال “الندوة اللبنانية” من دون الحضور الفوري لإسم ميشال أسمر، قبل غابة من أسماء المثقفين والمفكرين والسياسيين الذين وقفوا على منبر “الندوة” محاضرين.
دور كلٍّ من حبيش وأسمر ونشاطه التأطيري، وليدا خبرة وممارسة وعلاقات وميول ثقافية سابقة في حياة الرجلين على إنشاء كلٍّ منهما إطاراً منظماً لنشاطات يشارك فيها سواه من أمثاله. إنهما دور وإطار يشيران الى ما يسمّى “المنشّط/ المنسّق الثقافي” الذي ينصبُّ عمله على توظيف رؤيته وجهده وعلاقاته في إقامة جسور وفضاءات للتعارف والتبادل والتفاعل والتثاقف ما بين ناشطين وفاعلين في ميادين الثقافة والافكار والأدب والسياسة والصحافة. هذه الأطر والجسور، أكانت مؤسسة أم منبراً أم صحيفة أم مجلة أم حلقة في مقهى، هي ما يسمّيها المفكر الالماني يورغين هابرماس “دوائر العلانية العامة” في كتاب له بهذا الاسم، معتبراً أن لا قيامة للمجتمع المديني، المدني الديموقراطي، من دون وجود هذه الدوائر وتوسعها، وتكاثر روادها وسجالاتهم، وتعدّد آرائهم وتفاعلها. في قلب هذه الدوائر المتناسلة، المتقاطعة وغير الثابتة والزئبقية، يولد المؤطّر أو المنسّق أو المنشّط، ودوره كقطب يعمل على تشبيك مبادرات وعلاقات ومراكمتها وإطلاقها.
هذا ما باشره وبادر اليه فؤاد حبيش بعد سنة واحدة على إصداره “المكشوف” في العام 1935. وهذه حال ميشال أسمر حين تأسيسه “الندوة اللبنانية” بعد حوالى 10 سنين. لكن الدور الذي تصدى له كلٌّ منهما لم يولد فجأة ولا من فراغ، بل سبقته خبرات وتجارب مهّدت له في حياة الرجلين الشخصية والمهنية والثقافية، وفي التجربة التاريخية العامة التي تتجاوز حياتهما الى البيئة الاجتماعية التي صدرا عنها ونشأا فيها وتفاعلا في إطارها الزمني (حقبة ما بين الحربين العالميتين) والاجتماعي (جبل لبنان وبيروت) والمهني (الصحافة ومنتدياتها وحلقاتها الأدبية). في هاتين الحقبة والبيئة، تكونت العوامل والخبرات والتجارب التي أدت، على نحو بطيء، الى نشوء دوائر العلانية العامة اللبنانية، الثقافية والسياسية، فنمت في هذه الدوائر أشكال تعبير ومهن وأنماط تفكير وتذوق وتواصل وشبكات علاقات جديدة، نجمت كلها عن تحولات مديدة في جبل لبنان وبيروت، اللذين قامت بينهما، منذ أواسط القرن التاسع عشر، جسور تواصل وتفاعل مهّدت لتكوّن النواة الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية لدولة لبنان الكبير الوليدة في العام 1920.
بدأت تلك الجسور والدوائر تنشأ وتنمو في إطار ما سمِّي التحديث أو الاصلاح العثماني، وتزامن نموّها مع منح السلطان العثماني امتيازات واسعة لقناصل الدول الأوروبية وتجّارها وبعثاتها التبشيرية والتعليمية وجالياتها في ولايات الأمبراطورية طوال تفككها المديد. وهذا ما أدى الى ولادة نوع جديد وغير مسبوق من الحراك الاجتماعي والحريات العامة. ولعل توسع قاعدة التعليم الارسالي الأوروبي والاميركي، ونشوء الصحف وتكاثرها الى جانب المنتديات والجمعيات على اختلافها، هي العلامات الأبرز على ذلك الحراك وتلك الحريات في كلٍّ من مجتمع جبل لبنان وبيروت التي توسعت عمرانياً وخرجت من أسوارها القديمة، وتكاثرت مدارسها الارسالية، ونشأت فيها جامعتان سرعان ما صارتا، بعد قيام دولة لبنان الكبير، الأهم في الشرق الاوسط.
الضابط اليتيم في حمّى الصحافة والأدب

يحتاج انشاء سيرة تأريخية لفؤاد حبيش بوصفه منشّطاً صحافياً وأدبياً، ولدوره واثره في الحركة الصحافية والأدبية، الى عمل تراكمي واسع، بطيء ومتنوع المصادر، يفوق ما يحتاج اليه انشاء سير لأعلام الأدب والصحافة ونجومهما المكرسين مع إنتاجهم انصاباً في الذاكرة الجماعية العامة.
يقوم هذا العمل على تقصي المعلومات والأخبار، جمعها وتنسيقها، تأويلها واستدخال عناصرها وخيوطها في نسيج متنوع الالوان والسياقات. وهذا لا توفره الا مخيلة تأريخية تعتمد التأليف والتوليف والتركيب اسلوباً يقترب من الفن الروائي الذي يخالف اسلوب السرد الميكانيكي الحدثي المتسلسل والشائع تكراراً في المصادر المدرسية والاكاديمية. فهذه غالباً ما تحوّل التأريخ سلسلة من الاخبار الجامدة عن الحوادث والوقائع، تبدأ بولادة الاشخاص، وتتوقف في محطات من حياتهم، معروفة وشائعة كالمحفوظات، وتنتهي بموتهم. اما السيرة التأريخية للأشخاص وأدوارهم، فدأبها الاقتراب بهم ليكونوا شخصيات روائية، وهذا ما لا تدّعيه هذه المحاولة عن فؤاد حبيش الذي ولد العام 1904 في بلدة غزير الكسروانية صادراً عن عائلة من العائلات الاقطاعية، مضى اكثر من 50 سنة على بدايات تصدع عالمها مع تصدع نظام الاقطاع والامارة، بعد انطلاق الحركات العامية الفلاحية في جبل لبنان اواسط القرن التاسع عشر. سبق هذا الانطلاق بروز السلك الديني الكنسي والرهباني ودوره في التنظيم والتأطير الاجتماعيين في مجتمع الجبل، فتوسعت قاعدة التعليم المحدث المتصل بذلك السلك وبالبعثات التبشيرية والتعليمية الاوروبية والأميركية، وتراجع دور ملكية الارض والعلاقات والعائلات الاقطاعية في مراكمة القوة والثروة والنفوذ، وجرى توظيف ذلك الدور وتلك العلاقات في سياقات جديدة مدارها الارتقاء الاجتماعي والثقافي والمهني عبر التعليم والتجارة.
الشذرات القليلة المتداولة من سيرة فؤاد حبيش الحدثية، تشكل مرآة لهذين الحراك والتحول. تروي سهام ايليا ابو جودة في بحثها الجامعي حول “الحركة الادبية في لبنان 1935 – 1845 من خلال جريدة “المكشوف”، الذي أعدّته العام 1997 في الجامعة الاميركية في بيروت، ان “الشيخ اسد حبيش (والد فؤاد) كان مدير القلم التركي في متصرفية جبل لبنان. وأتقن العربية والتركية والايطالية”، لكنه توفى حينما لم يكن ابنه فؤاد قد تجاوز الطفولة. بعد تعلمه الاولي في مدرسة “المزار” بغزير، أُدخل في العام 1913 الى مدرسة الحكمة التي أسسها في بيروت المطران يوسف الدبس (1833 – 1907). لكن سنوات الحرب العالمية الاولى سرعان ما أعادت الفتى الى مسقطه واهله، حيث تابع تعليماً بدائياً في “مدرسة تحت السنديانة”. ويبدو انه عاش فتوة، بل طفولة، شقية في تلك السنوات، متنقلا بين غزير وجونيه مع رفاق له يلعبون القمار والبليار وطاولة الزهر. ما ان انتهت الحرب حتى استدعاه ابناء عمومته الى القاهرة، فسافر اليها وامضى فيها سنتين دراسيتين في “المدرسة العلمانية الفرنسية” قبل عودته الى لبنان العام 1922، فلم يستطع الدخول الى كلية الحقوق في جامعة القديس يوسف. كان الجيش اللبناني في بداية تأسيسه غداة قيام دولة لبنان الكبير تحت سلطة الانتداب الفرنسي، فالتحق فؤاد حبيش بالمدرسة الحربية التي انشأها الفرنسيون في دمشق، وتخرج منها برتبة ضابط مترجم العام 1924، فأمضى 10 اشهر على رأس قسم الترجمة العسكري في حماة، قبل عودته الى بيروت.
شبكة علاقات القربى لعبت دوراً في زواجه من يمنى لحود ابنة خالته زاهدة حبيش التي يعود نسب امها الى عائلة الدحداح. للقربى حضورها في صلة فؤاد حبيش بفؤاد شهاب (قائد الجيش اللبناني لاحقاً) الذي تنتسب امه الى آل حبيش. العائلات هذه، الى كسروانيتها، كانت من عائلات المقاطعجية التي تعلوها مرتبة آل شهاب الاميرية، وأدى انهيار النظام الاقطاعي ومراتبه الى تشتتها في المهاجر والاعمال المحدثة، ومنها الصحافة التي استهوت فؤاد حبيش في وقت نشاطها وازدهارها القوي اللافت في العاصمة اللبنانية الجديدة آنذاك. ففي بيروت العشرينات كانت تصدر عشرات الجرائد التي اجتمعت معظم مكاتبها في الوسط المديني حول ساحة الشهداء وفي الاسواق. تحلّق في تلك المكاتب مئات من الشبّان المتعلمين، مأخوذين بسحر الكلمة والادب، وبعهد جديد للحرية في التعبير والحراك الاجتماعي والسياسي، وفي تداول الرأي في العلانية العامة. وفي تلك المكاتب وعلى صفحات الجرائد، تجاور وتخالط ابناء العائلات من اصحاب النسب والمراتب القديمة وابناء العامة العصاميين المتعلمين الذين كانت غالبيتهم من المسيحيين.

عصبة العشرة
لم يبق فؤاد حبيش هاوياً للصحافة، بل ترك عمله ضابطاً مترجماً في المؤسسة العسكرية، وانخرط في المهنة الجديدة الواعدة، فحرر في ما لا يقل عن اربع جرائد، قبل ان يلتحق بـ”المعرض” الجريدة الاسبوعية الادبية، لمؤسسيها وصاحبيها ميشال ابو شهلا (1898 – 1965) وميشال زكور (1893 – 1937). كانت “المعرض” من اهم الجرائد في بيروت النصف الثاني من العشرينات والنصف الاول من الثلاثينات، وتحلق على صفحاتها وفي مكتبها كتّاب بارزون، انشأوا في العام 1930 شلة ادبية – صحافية ناشطة عُرفت وذاعت صيتها باسم “عصبة العشرة” التي تألفت نواتها من أربعة: ميشال ابو شهلا، الياس ابو شبكة، خليل تقي الدين، ولولبهم الصحافي فؤاد حبيش. احياناً يقال ان واحدهم كان يكتب ويوقّع بعدد من اسماء مستعارة، فصاروا عشرة على صفحات “المعرض”، بينما هم اربعة في مكاتبها يتحلق حولهم: كرم ملحم كرم، يوسف ابرهيم يزبك، توفيق يوسف عواد، عبدالله لحود، ميشال اسمر (اسس لاحقاً عصبة ادبية هي “ندوة الاثني عشر، قبل انفراده بتأسيس “الندوة اللبنانية” العام 1946). اما سادس الستة المتحلقين حول نواة “عصبة العشرة” فكان تقي الدين الصلح. واللافت ان الصلح كان يهوى التمثيل المسرحي قبل الصحافة والى جانبها، وفقاً لما كتبه جان داية في “ملحق النهار” في 23 ايار 2010. ففي العام 1924 لعب تقي الدين الصلح، ايام كان طالباً في الجامعة الاميركية في بيروت، الدور الرئيسي في مسرحية “قضي الامر” لكاتبها سعيد تقي الدين، رئيس جمعية “العروة الوثقى” في الجامعة.
هذه الادوار والتجارب المتدافعة والمتقاطعة في مسارات ذلك الجيل الشاب: المسرح، الصحافة، الجمعيات او “العصب” الادبية والصحافية، من علامات ولادة اطر ودوائر وشبكات متنامية في حياة مدينة جديدة مسرحها وسط بيروت القديم، حيث توسع انتشار المسارح والمقاهي ودور السينما والملاهي ومكاتب الصحف التي كانت محطات في مسيرة كثيرين من شبّان العائلات القديمة والجديدة الى النيابة والوزارة والسلك الديبلوماسي الناشئ.
خاضت “عصبة العشرة” على صفحات “المعرض” معارك ادبية حامية ضد التقليد في الادب والشعر “المخضرم” الذي كان يمثله بشارة الخوري (الأخطل الصغير) صاحب جريدة “البرق”، فشكلت تلك المعارك محوراً اساسياً في الحياة الأدبية والصحافية آنذاك.
مما كتبه الياس ابو شبكة عن لقاءات “عصبة العشرة” في مكتب ادارة تحرير “المعرض” حيث كانوا يتناولون طعام الغداء ويتناقشون في شؤون الادب والسياسة، يستشف القارئ أن النراجيل وكركراتها، وربما الطرابيش على بعض الرؤوس، كانت حاضرة في تلك الجلسات التي يسمّي شاعر “غلواء” و”أفاعي الفردوس” جلاّسها الاعضاء “الجنود الروحيين (الذين) لن تقف عينك على مشهد ألطف وأكمل من مشهدهم”. وهم كانوا يكتبون مقالاتهم النقدية اللاذعة بأسماء مستعارة: “جوّابة”، “منخل” لفؤاد حبيش. “غضبضب”، “رسام” لالياس ابو شبكة. كانت هذه المقالات تتصدى لـ”شيوخ الادب التقليدي” ولرجالات السياسة الذين “هجاهم” ابو شبكة في مقالاته ورسومه الكاريكاتورية لـ”هتك ستورهم واقنعتهم المستعارة”. لذا عطّل رئيس الجمهورية شارل دباس “المعرض”، فظلت صامتة حوالى سنتين اواسط الثلاثينات. وحين عادت الى الصدور كان “فرسانها قد تفرقوا، فالتزمت جانب الاعتدال والاتزان”، قبيل الوفاة المفاجئة العام 1937 لأحد مؤسسيها، ميشال زكور، وهو في منصب وزير في الحكومة، فانتقل نشاط “عصبة العشرة” الى “المكشوف” التي اسسها فؤاد حبيش.
شبكات عائلية ومؤسسات
اللافت أن هذه الشذرات من سيرة مؤسس “المكشوف” كتبها عيسى فتوح في حزيران 2005 في العدد 240 من “مجلة الجيش” اللبنانية، ضمن تحقيق في 4 حلقات عن “الصالونات الادبية في لبنان”. فما الذي يحمل مجلة عسكرية على كتابة مثل هذه التحقيقات؟! الجواب: الى تخرجه ضابطاً مترجماً من المدرسة الحربية في دوراتها الأولى، كانت تربط فؤاد حبيش صلة مصاهرة باللواء فؤاد شهاب. وهذه واقعة جزئية من سلسلة من امثالها تشير الى ان المدرسة الحربية في المؤسسة العسكرية اللبنانية منذ بدايات نشوئها، استقطبت شباناً من شبكات عائلية محددة تجمعها علاقات القربى والمصاهرات. من هذه الشبكات: آل البستاني، آل لحود، آل شهاب، آل نجيم، وسواهم من العائلات التي تكاثر ابناؤها بين كبار الضباط والمراتب العسكرية القيادية العليا. والشبكات العائلية لها دورها المماثل تقريباً في سلك الرهبانيات الذي شكّل رافعة اساسية لأبناء هذه الشبكات وسواهم من العامة في التعليم الرهباني والارسالي في المجتمع المسيحي، قبل أن تلتحق به (التعليم) وتستفيد منه فئات اجتماعية من المسلمين. لكن في حالة فؤاد حبيش، هنالك عامل اضافي مهني وثّق صلته بالمؤسسة العسكرية. فبعد تأسيسه “دار المكشوف” للنشر، تعهد اصدار مجلات كثيرة: “المدرسة”، الاذاعة”، “الراديو”، “الجندي اللبناني”، “الشرف العسكري”، “الحرب”، و”قرأت لك”. وهذا ما حمل “مجلة الجيش” على استذكاره في العام 2005.
يبقى أن نشير في هذا السياق الى أن “دار المكشوف” كانت “امبراطورية نشر” أدبي ولقطاعات مهنية وتربوية ما بين الثلاثينات والخمسينات من القرن العشرين، ايام كانت الكلمة المكتوبة في الصحف والمجلات، والكلمة المسموعة عبر الاذاعات، الفضاء الاساسي الأرحب للتواصل والتعبير والترفيه وتناقل المعلومات لدى الفئات الاجتماعية والعمرية والمهنية المختلفة في تلك الحقبة التي شهدت طفرة في اصدار مجلات ومطبوعات ترفيهية واعلانية ومعرفية خاصة بقطاعات جديدة ناشئة ومتوسعة. لكن اللافت ان هذه القطاعات المهنية والتربوية، استنكفت عن انتاج ما تحتاجه من مطبوعات وعن اختبار طاقاتها في نقل تجاربها الى مجال الكتابة، بتلزيم تحرير واصدار ما تتطلبه من المطبوعات الى هيئات تحرير ومؤسسات نشر محترفة وغريبة عنها وعن حاجاتها وتجاربها وخبراتها المهنية. هذا فيما كانت “دار المكشوف” اول دار لبنانية ارست تقاليد مؤسسية للنشر، بفصلها هذه المهنة عن مهنتي الطباعة وبيع الكتب، بعدما كان الناشرون أصحاب مطابع ومكتبات تجارية.
أخبار الشهوة المدبلجة

لا نملك معطيات وافية تمكننا من تقديم شبكة العوامل التي حملت الشيخ فؤاد حبيش حينما كان في مطلع الثلاثين من عمره، على الخروج على التقاليد السائرة في العمل الصحافي الناشط والمزدهر، وعلى أنواع المادة التي كانت تقدمها الجرائد إلى القراء في بيروت ثلاثينات القرن العشرين.
يتطلب تقديم تصور ما عن هذه العوامل، العودة الى ما كان يكتبه حبش وسواه في “المعرض” وسواها، كما يتطلب أيضاً توافر سيرة اجتماعية – ثقافية ما، حقيقية للرجل، لم تُكتب بعد، شأن غيرها من سير روّاد الصحافة وكتّابها في تلك الحقبة، وشأن التأريخ الفعلي للصحافة والعمل الصحافي وموضوعاته. وفي ظل غياب مثل هذه السير وذلك التأريخ، يصعب اجلاء دواعي فؤاد حبيش الى اصدار جريدة اسبوعية تبدو اليوم اقرب الى جريدة الأمس لـ”الاثارة الجنسية” ولما يحفّ بها من صور وأهواء ومن حوادث وأصداء اجتماعية. ويظل ضرباً من الحدس التقريبي التعرف إلى ما دار في وعي الرجل ومخيلته كي ينشئ تلك الجريدة التي لا ندري إن كان أحد ما في ثلاثينات بيروت والقاهرة، قد سبقه في انشاء مثيل له، فاستلهمه حبيش ونسج على منواله: جريدة توقف مادتها كلها تقريباً على إثارة مدارها ومحورها النساء والجنس، كما تحضر أخبارهن وأخباره في بعض الحصف والمطبوعات الغربية، الشعبية والرائجة آنذاك، على الأرجح. إثارة يجري استلهامها، ترجمتها ودبلجتها (على نحو ما تجري اليوم دبلجة المسلسلات التلفزيونية المكسيكية والتركية)، لتقديمها في مطبوعة عربية اللغة والتهويم والتخييل الاجتماعيين والثقافيين، ليخالف حبيش في هذا سربه الصحافي والكتابي في “عصبة العشرة”. يتبادر هنا حدس ما، بعيد، بأن حبيش رغب في ان يقدم مادة صحافية تكسر الجدية والرصانة السائدتين في الكتابة آنذاك. كما يتبادر حدس آخر بأن ما دار في وعيه ومخيلته، استلهم على نحو معكوس أشعار صديقه في “العصبة” إلياس ابو شبكة. ففي مقابل حمّى الشهوات وفحيحها الأسود الآثم والملتاع، وفي مقابل آلام حُرَقِها الناجمة عن عدم تلبيتها جرّاء تمنّع المرأة وامتناعها وشبقها المستتر مع “خيانتها” واختبائها خلف حجب التقاليد والحشمة والفضيلة، كما في قصائد “أفاعي الفردوس” – التي يقال ان ابو شبكة كتبها متأثراً بـ”أزهار الشر” البودليرية وبالرومنطيقية أو “الواقعية الرمزية” – في مقابل هذا كله، عمل فؤاد حبيش على دبلجة مادة صحافية عن فحيح الشهوات والأهواء وأصدائها في أخبار الحوادث والوقائع الاجتماعية والقصص الاوروبية في حقبة ما بين الحربين العالميتين. لكنه نزع عن ذلك الفحيح مشاعر الإثم واللوعة وآلام حرقها، وقدّمه في أسلوب نثري، قصصي وإخباري، يجمع الإثارة والتشويق واللهو إلى واقعية حسية مفترضة.

رسول العري والبصبصة
استهل فؤاد حبيش تسمية جريدته الاسبوعية الجديدة “المكشوف” من فكرته وتصوّره عنها وعن مادتها ومتطلبات جمهورها المفترض: الرغبة في هتك الأسرار والحجب عن المرأة وجسمها. وذلك بتعريضها في الإخبار والقص المفترض انهما حدثيان وواقعيان، إلى حساسية جديدة هي وليدة السفور والتعرية، وفقاً لمبدأ الواقع الإباحي، على خلاف مبدأ الإعلاء الطهراني والروحاني للرغبات والشهوات، ولإستتار النساء وأجسامهن خلف حجب التقاليد المحافظة والفضائل الاخلاقية والاجتماعية البالية. غداة تأسيسه “المكشوف” وإصدارها، نشر حبيش “بيانه التأسيسي” وبيان جريدته، في كتابين هما “السجينات – بحث في حب النساء الشاذ”، و”رسول العري” الذي صار لقباً له، وإسماً آخر لجريدته التي جرى تداول اسمها في صيغة المذكّر، فقيل وكُتب “هذا المكشوف”، بعدما صدرت اسبوعياً ابتداءً من أول أيار 1935. اللافت ان أعدادها الأولى خلت من اسماء كتّاب أو محرّري مادتها ومدبلجيها، سوى اسم “محررها المسؤول” فؤاد حبيش فقط. على صفتحها الأولى في عددها الأول “قصة لم يسبق نشرها” هي “قصة غرام النبيلات” إلى جانب صورة امرأة تنكشف أجزاء مثيرة من جسمها. وتكرُّ سبحة أشباه هذا العنوان على صفحات العدد الأول كلها: “العري في الحب – أتفضل أن تكون عارياً أم لابساً؟”، “الحب في الكتب”، تحته عنوان فرعي: “زوجة متطرّفة في تقواها”، ثم “القضايا القذرة والمحاكمات السرية”، “مدرّسة لا تكره الشهوات”. طوال السنة الأولى من صدورها تتعزّز مثل هذه العناوين والأبواب وتتناسل متزايدة، كأنها قصص وحكايات متسلسلة: “قصة زواج حكيم” (طبيب)، “المطارحات الغرامية التي تفضلها المرأة”، “كيف تحب رجلاً متزوجاً”، “العاشق الحقيقي: واجبه قبل الحب وفيه وبعده”، “جسد ملتهب”، “مخدر جديد يستعبد النساء ويوقظ شهواتهن”، “ما هي اللذة التي تفضلها في الحب: فوق الصخور، القبلة الجارحة، العضة في الأذن؟”، “الغرام في اسبانيا يشمل الكبار والصغار”، “المغازلة في السينما: بغاء القاصرات، أسعار الحب”، “كيف سحر هتلر الفاتنة بريجيت”، “اللهو والحب في لندن”، “الجرائم في بولونيا”، “ريق امرأة يشفي من سم الأفاعي”، “مومس تتحدث إلى ابنها”، “السحاقيات عند اليونان”، “الفحش المقدس في بلاد المهاتما غاندي”… إلخ.
على صفحات 33 عدداً صدر الأخير منها في 7 كانون الثاني 1936، ظل “مكشوف” فؤاد حبيش بوصفه “وان مان شو” تقريباً، رسولاً لهذا النوع من العناوين والكتابة الاسبوعية المترجمة والمدبلجة والمعدّة والمنقولة عن صحف ومطبوعات أوروبية معظمها فرنسية. إلى جانب هذه العناوين وموضوعاتها، صور اباحية لنساء ومضاجعات شديدة الإثارة، يقوم بحفرها على معدن الزنك حرفيّ أو فنّان “الزنكوغراف”، فتشير “المكشوف” إليه في بعض أعدادها باسم “بغدادي” الذي يبدو ان رقابة المطبوعات آنذاك أخذت تحذف بعض صوره الشديدة الإباحية. لذا أصدرت الجريدة بعض أعدادها بمساحات بيضاء على عدد من صفحاتها، بسبب حذف الرقابة تلك الصور.

المرأة محور الإعلانات
تتخلل هذه العناوين والموضوعات المثيرة إعلانات محلية تشير الى ظهور مهن وخدمات وسلع جديدة متناسبة مع “ثقافة السفور الإباحية” التي تشيعها “المكشوف”: “الدكتور جرجي ربيز الاختصاصي بالأمراض التناسلية”، “عيادة طبيب الأسنان” لطبيب في محطة الناصرة، “كريم هالينا المزيل للنمش”. بعض الاعلانات تحظى بمقدمات مثيرة مطولة: “ماذا يحب الرجل في المرأة؟”، والجواب: “جمالها الطبيعي الخلاب، صفاء الوجه، نقاء البشرة”. عليك إذاً بـ”كريم سندس”. ثم دعاية لـ”الشوكولا الوطنية، صنع معامل الجميل الشهيرة: تجدها خصوصاً في صيدلية الجميل بساحة الشهداء”. للاصطياف والفنادق والمطاعم والخمور حصتها من الدعاية: “نزل قاصوف في ضهور الشوير”، “فندق الهنود في دير القمر”، “عرق الزوق الفاخر”، “مطعم عارف الجديد المشرف على سينما روكسي”، “الويسكي اللذيذة الخالية من الضرر: أمباسادور”، “حتي إخوان لأوراق السفر إلى جميع أنحاء العالم”، وإعلان عن شركة جديدة لنقل المصطافين، وعن “دليل الاصطياف لمؤلفه اسكندر يارد”، وللاعلانات على صفحات “المكشوف” عليك ان “تخابر في شأنها الادارة في سوق اياس – قرب البركة”. إلى جانب حلقات “رواية” متسلسلة عنوانها “الإغواء” لأنيس دية، مقالة عن “بائعات اللذة في فرنسا ولبنان”، يرد فيها ان “حملات الصحف والأحاديث الخاصة أثمرت اخيراً عن ضرورة التساهل بالسماح لبائعات اللذة ممارسة حرفتهن في أماكن الاصطياف”، حيث تنقل الجريدة أخبار انتخاب ملكات للجمال في حمّانا وضهور الشوير. لذا نشرت “المكشوف” مقابلة مع المنتخبة الآنسة كيتا كفوري التي قالت: “تغريني المكشوف وأقرأها بلذة لأنها جريدة الجمال الحقيقي والفضيلة الحقيقية”.

استعارة أوروبا “السنوات المجنونة”
هذا غيض من فيض عناوين “عالم المكشوف” للسفور والعري في أعداد السنة الاولى من صدورها. يتخيل متصفح هذه الأعداد أن مادة الجريدة الاسبوعية أثارت عاصفة في مجتمع ثلاثينات المجتمع اللبناني والبيروتي. من الصعب التحقق من هذا الأمر من دون استطلاعات واسعة تبيّن وقع تلك المادة الصحافية على جمهور قرّاء تلك الحقبة التي عمل فؤاد حبيش فيها على إعداد مواد صحافية وكتابات أوروبية مثيرة، ترجمتها وتلخيصها ونشرها في “المكشوف”. كان العالم آنذاك يعيش في حقبة ما سُمّي في أوروبا “السنوات المجنونة”، أي العشرينات التي أعقبت الحرب العالمية الاولى (1914 – 1918). وهي سنوات مضطربة ومضطرمة بأنماط عيش وتفكير جديدة، منها رسوخ خروج المرأة الى العمل والحياة العامة واتساعه على نطاق جماهيري في البلدان الأوروبية، حيث شاع تحرر النساء من الأزياء القديمة التي كانت تلافيفها الكثيرة تغطي أجسامهن وتعوق حركتها. ويبدو أن فؤاد حبيش زار ألمانيا في مطلع تلك السنوات الأوروبية “المجنونة”، فتردد هناك على “نوادي العراة” حيث “أفراد من طبقات اجتماعية مختلفة، يمضون عطلهم، رجالاً ونساء، في الهواء الطلق، عراة، لتنقية أجسامهم من الأمراض”، على ما كتب حبيش نفسه في مقدمة كتابه “رسول العري” واصفاً رحلته الألمانية تلك التي كان قد نشر بعض فصولها مقالات في جريدة “الأحرار المصورة” في عنوان “العري في ألمانيا”. أما ذلك الكتاب فكان حصيلة ترجمة وتلخيص لكتاب “بلاد العري” للفرنسي شارل رواييه. كان دافع حبيش الى ذلك العمل “إيمان بأهمية الثقافة الجنسية القائمة على قواعد طبية وصحية يتوجب تلقينها للطلبة منذ نعومة أظفارهم”، فاتّهم، بعد نشره الكتاب بـ”الانحراف الخلقي”.
صديقه ادوار حنين قال في رثائه العام 1974 إنه كان “على ظاهر من التفلت منقطع النظير”، لكنني “ما رأيته يوماً إلا في جانب الخلق النبيل (…) مشدوداً الى الجبل بشروش لا أمتن: منها لآل حبيش ومنها لآل لحود ومنها للصخرة التي أدمت قدميه صبياً في غزير”. أما عديله أنطون غطاس كرم فقال عنه في السياق الرثائي نفسه: “إذا لقيته نضح بالبشر ثم زفّك العبث، كأنما الدعابة (عنده) جسر الى الحميم، وانزلاق اللسان أسلوب من المودة”. كثيرة هي الاشارات التي تؤكد أن حبيش كان سليط اللسان حتى “البذاءة” الساخرة، أو “الشتيمة بلهجته الكسروانية الشهيرة”، على ما ذكر أنسي الحاج، متذكراً “أناقته الأريستوقراطية”. هذه الصفات قد نجد مصدرها في محطات سيرة حبيش الاجتماعية والشخصية. فإبن عائلة المشايخ التي تفكّك عالمها القديم، والمقامر الصغير في فتوّته أيام الحرب العالمية الاولى، والمتخرج من المدرسة الحربية ضابطاً مترجماً، قال عنه أنطون غطاس كرم إنه كان “في انضباط الجندي، مؤرقاً (من الورق) يفلي صحف العالم، يخط بالأحمر، يترصد ثمار المطابع في كل فن، يجمع مختار الطرائف من المد العالمي، يطوّعه وفق قرائه، يلطّفه، يضغطه مادة لصفحة” في جريدة، أيام كانت الصحافة تنطلق ناشطة مزدهرة في بيروت ولبنان العشرينات والثلاثينات. فهل استشفّ فؤاد حبيش أن سوق الصحافة وجمهورها المحليين متعطشان توقاً الى مطبوعة جديدة تتفرد في المجتمع المحلي بالتعبير عن شبق محموم، مكبوب أو مكتوم، يريد أن يسفر عن نفسه في العلانية العامة؟ لكن لا حبيش ولا ذلك المجتمع كانا يمتلكان ثقافة وتجربة وخبرات ولغة تمكنهما، بغير الترجمة والتلخيص والدوبلاج، من التعبير عن ذلك التوق الشبق الى السفور. لذا أقدم الصحافي، “رسول العري”، وكذلك مجتمعه، على استعارة مادة توقهما من أوروبا “السنوات المجنونة”. مذذاك، قبله وبعده، تعمل ثقافتنا ولغتنا العربيتان على استعارة عالم الحداثة الأوروبية وترجمته على نحو سيئ غالباً، ونشره في شتى ميادين حياتنا المحلية.
الخيال الصحافي السبّاق
في العدد 33 من “المكشوف”، ذاك الذي سبق انقلابها جريدة للأدب والأدباء في مطلع العام 1936، حاول توفيق يوسف عواد إدخال استعارة فعل أوروبا في نسيج الاجتماع البيروتي، فكتب في أسلوب قصصي تحقيقاً عن “بنات المدينة” اللواتي يعملن في المؤسسات والمخازن والمكاتب، كما يعمل الرجال. طائفة البنات العاملات “لم يكن لنا بها عهد قبل الحرب الكونية الاولى – كتب عواد – ويجب أن نحسب لها حساباً اليوم”، بعدما بلغ عددها “المئات” في بيروت. وينقل الكاتب مقتطفات من محادثته بعض بنات هذه الطائفة الجديدة. إحداهن تقول إنها تعمل للحصول على مبلغ من المال لتشتري به “كل ما تشتهيه نفسي: فساتين، برانيط، عطور، كلسات، وبطاقات سينما”. وهي “تحب الجمال أكثر من التحصن في المنزل”. أخرى تقول إنها “تحب الحرية، الخروج وركوب الترامواي، وأن يمشي ورائي شاب يسارقني النظر، فأضحك عليه في سرّي، وأتمتع بتلك الرعشات تنزل من قلبي الى أخمص قدمي”. ثالثة تقول: “أحب العودة الى البيت، ليسألني والدي أين كنتُ، فأجاوبه: كنت في الشغل”. رابعة تعمل في مخزن وتتقاضى 10 ليرات سورية في الشهر، وتقول إنها تُعيل بها أمها الأرملة وإخوتها اليتامى.
أخيراً يخلص عواد متسائلاً: “أنستطيع القول إن 50 في المئة من العاملات يحافظن على عفافهن؟”. جازماً يجاوب “السالمات لا تتجاوز نسبتهن 5 في المئة. العذراء منهن نصف عذراء، وهي تعطي كل شيء سوى خيط عنكبوت. التي تعطي بسخاء إنما تعطي مدير المكتب أو المخزن أو المؤسسة، من دون أن تبخل في الشارع”. ويختتم الكاتب في أسلوبه القصصي: “في الصباح والمساء، عندما تتزاحم الأقدام العالية والفساتين القصيرة على الأرصفة، تجد كثيرات يقفن في محطة ترامواي أو على ملتقى طرق، ينتظرن العشاق. إنها ظاهرة فرحة لذيذة، لكنها لا تخلو من خطر. ومتى كانت الحرية خالية من الأخطار؟!”.
رسول العري يستعيد صواب الأدب

في عددها الأربعين مطالع أيار 1936 صدّرت “المكشوف” صفحتها الأولى ببيان أعلنت فيه “مفاجأة كبرى سارة لم يحلم بها القراء”: سوف تصير “جريدة جديدة بشكلها وروحها ومادتها وكتّابها” لتصبح لسان حال النهضة الأدبية في هذه الربوع بما تنشره من مقالات تدبّجها أقلام نخبة من أدباء هذا الجيل.
تطرق “المكشوف” “مواضيع السياسة بإخلاص لخدمة البلاد، وتعالج مواضيع الأدب (لـ) تحرير الأدب العربي من عبودية التقليد وعبودية التجارة”. ويضيف البيان: “ستبحث المكشوف في الفن والعلوم والسينما، وقد تمكّنا من الاتفاق مع عدد من كتّابنا الممتازين (الذين) نفاجئ بهم قراءنا”. أما ما سينجم عن هذا التغير، بل الإنقلاب، بعد أكثر من سنة على صدور الجريدة، فيقصره البيان على أن “المكشوف ستصبح الجريدة التي تقرأها العذراء في خدرها دون أن تلاقي في قراءتها ما درجت عليه حتى اليوم، (وهو) ما عزمنا على اهماله تماماً”.
التدبيج والعذارى
الى النبرة الإعلانية الدعائية البارزة في مطلعه، ينطوي القاموس اللغوي للبيان على عبارات وكلمات قد يكون جامعها ما سمّي “النهضة الأدبية” بوصفها حركة عامة صِيغ مفهومها منذ نهايات القرن التاسع عشر ما بين مصر ولبنان، مستلهِماً حركة التنوير الأوروبي، وصار دارجاً بين المثقفين والكتّاب والأدباء العرب واللبنانيين، ومدار سجالاتهم وانقساماتهم وحامل رغباتهم في التجديد والتقدم والتحرر، طوال النصف الأول من القرن العشرين. مثل معظم البيانات النهضوية الأدبية العربية واللغة التي تعتمدها، تظهر في بيان “المكشوف” عبارات وكلمات وصياغات إنشائية تعود الى “لاوعي لغوي” وتعبيري يُفترض أنه سابق على النهضة الأدبية، ويخالف مضمونها الذي قد تكون العبارة الإعلانية في مطلع البيان هي الأقرب إليه. أما العبارات والكلمات الصادرة عن “لاوعي لغوي” مرسل ويخالف المضمون المفترض للنهضة، فهي من أمثال: “هذه الربوع”، “تدبجها أقلام”، “العذراء في خدرها”. ذلك أن هذه الكلمات تنتمي الى لغة عربية فائتة فقدت صلتها بوقائع الحياة اليومية ومخيلتها وأفعالها وعلاقاتها السائرة، وفقاً لما رغبت “المكشوف” نفسها ان تحمل رايته في حلّتها السابقة على البيان بوصفها “رسول العري” و”كشف الستر” عن الرغبة والوقائع والحوادث والأفعال والعلاقات الناجمة عنهما في الحياة الاجتماعية والخاصة. لكن مراجعة عناوين ومقتطفات من مادة “المكشوف” الصحافية في سنة صدورها الأولى، بيّنت أن تلك الرغبة – الرسالة جاءت مترجمة ومدبلجة عن مواد صحافية أوروبية (فرنسية غالباً)، ومنقطعة الصلة بأحوال المجتمع المحلي ووقائعه وحوادثه في معظم الحالات، ما خلا الإصرار على طلب الإثارة في ما يتصل بشؤون النساء وأجسامهن وملبسهن وشهواتهن وشهوات الرجال، تلك التي دأبت الجريدة على نشر أخبارها وحكاياتها المترجمة في علانية عامة، صحافية ناشطة ومزدهرة في بيروت ثلاثينات القرن العشرين. إذ كيف يمكن الحديث عن إرادة العري والسفور والرغبات والعلاقات والحوادث الناجمة عنهما، في لغة تستعيد كلمات مثل العذارى والخدور والتدبيج والربوع؟ والحق أن فعل التدبيج ينطبق تماماً على معظم مقالات “المكشوف” الصحافية المغفلة التوقيع في طورها الأول “رسولاً للعري”. الفعل نفسه حاضر في بيانها الأدبي الجديد الذي يزفّ الى قرائها بشارة صيرورتها جريدة أدبية، استقطبت قولا وفعلا نخبة واسعة من كتّاب لبنان أولاً، وسوريا تالياً، في الأدب والصحافة في عقدَي الثلاثينات والأربعينات من القرن العشرين، على ما تبيّن مراجعة أعدادها ما بين العدد 33 و500 تقريباً، قبل توقفها عن الصدور مطلع الخمسينات.
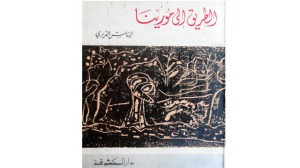
“لايف ستايل” الثلاثينات
لا ريب في أن كاتب البيان الأدبي، أو المشارك في كتابته، هو مؤسس “المكشوف” الشيخ فؤاد حبيش الذي روى في صفحة داخلية من العدد المنشور فيه البيان، أن “عائلة هاي لايف”، أي مرموقة اجتماعياً و”مثقفة” وتتألف من “أم وأب و7 أولاد بينهم فتيات”، كان “كل منهم يشترك سراً” في “المكشوف” التي تُرسل اليه أعدادها “على عنوان خاص” به وحده منفرداً. تغيب في هذا الخبر كلمتا العذارى والخدور، وتحضر كلمة فتيات وعبارة “هاي لايف” الأجنبية، كما يقال اليوم “لايف ستايل” في لغة الاعلاميات التلفزيونيات اللواتي غزا حضورهن وغزت لغتهن الصحافة المكتوبة. الأرجح أن حبيش في “مكشوفه” في طورها الأول ما قبل الأدبي، قدّم في منتصف ثلاثينات القرن العشرين مادة صحافية سبّاقة ورائدة من نمط “اللايف ستايل”، مشوباً بالإثارة. هذه الثقافة في نموذجها اللبناني والعربي الراهن، هي شكل من أشكال ثقافة العولمة الما بعد حديثة (البوست مودرن) التي تختلط فيها انماط تفكير وتعبير ونظر وسلوك غير متجانسة، بل عشوائية، صادرة عن “لاوعي” مرسل، كما كانت تختلط في الثلاثينات في لغة فؤاد حبيش كلمات وعبارات “هاي لايف” وفتيات وعذارى وخدور، الصادر كل منها عن فضاء لغوي مختلف عن الآخر، ومتعارض معه. كان يمكن ان نضرب صفحاً عن هذا التعارض العشوائي، ونقدّره تقديراً مختلفاً، لو أننا في معرض من فنون التجهيز الرائجة منذ سنوات في الفنون البصرية الما بعد حديثة.
عطفاً على بيان “المكشوف” الأدبي الجديد، تفصح إشارة حبيش الى عائلة المشتركين السريين في جريدته حينما كانت “رسولاً للعري”، عن أن العذارى كنَّ من قرائها، لكن خارج خدورهنّ البيتية والعائلية التي صار يمكنهن أن يقرأنها فيها مطمئنات بعد تحولها جريدة أدبية. هذا يشير الى أن “المكشوف” في حلتها السابقة كانت علنية وسرية في وقت واحد: مطروحة علناً في سوق المطبوعات الناشطة، وللمشتركين الذين يلتهمون مادتها الصحافية كل بمفرده وفي السر أو الخفاء عن الآخرين. وهذا يجعل القارئ بصَّاصاً على ما يقرأ، على رغم أن ما يقرأه مطروح علناً في السوق، من دون أن تلغي هذه العلنية والغفلية حذره من تداول الجريدة وقراءتها. أما بعد تحولها جريدة للأدب والأدباء فسيزول الخوف والتسري والقلق واللاطمأنينة أثناء قراءتها. وبسخريته اللاذعة يؤكد حبيش أن “عائلة الهاي لايف” التي يصفها بـ”المباركة” متهكماً، “ستشترك” علناً في “المكشوف” الجديدة “بعدد واحد فقط”، ليصير عددها الأسبوعي مطروحاً في البيت لجميع أفراد العائلة، يتناوله كل منهم بدعة مطمئنة، لا أثر فيها لذلك القلق المشوّق المثير الذي كان يجعل الجريدة واسعة الانتشار كنار في الهشيم، أو كسلعة ممنوعة – مرغوبة يجري تداولها فردياً في سوق سوداء. وقد يكون هذا مصدر قوة حضور “المكشوف” وانتشارها السريع في سنتها الأولى، قبل توسلها بهذين الحضور والانتشار وتوظيفهما في تحويلها جريدة للأدباء والأدب في علانية عامة “بيضاء” لا أثر فيها للسر والتسري والبصبصة على انفراد وفي الخفاء. والحق أن هذا ما يتحسر عليه فؤاد حبيس “رسول العري والإثارة”، تحسراً موارباً، ربما لم تشفِه منه القوة المعنوية الموعودة لجريدته التي قد يكون علَّل نفسه وواساها بقوله في البيان الجديد إن العذارى سوف يواصلن قراءتها، لكن مطمئنات في خدورهن. لكن هذا ليس أمراً مؤكداً، إذ متى كان الأدب وصحافته قبلة قلوب العذارى ورغباتهن؟ فحبيش يؤكد أن “المكشوف الأدبية” ستتدنى مبيعاتها وأعداد مشتركيها. لكن المؤكد أيضاً أنها في الحالتين، برغم قصر مدة حالتها الأولى، جعلت من فؤاد حبيش رائد صحافة ونشر طوال ما لا يقل عن 15 سنة في حقبة سميت حقبة “المكشوف” في صناعة الصحافة والنشر الأدبيين.
الانقلاب الأدبي
صدر العدد الأول من “المكشوف” في حلتها الأدبية الجديدة في 5 نيسان 1936، حاملا الرقم 43. على صفحته الأولى قائمة بأسماء الأدباء والشعراء المشاركين في تحريره، وفق الترتيب الأبجدي. تلي القائمة افتتاحية غير موقّعة، عنوانها لافت: “دستور 1926 للأحوال الشخصية: تشريع الطوائف والاعتراف بها”. موضوعات العدد تنبئ بأن معدِّيه أصحاب خبرة ثقافية وأدبية، وبذلوا جهداً في مناقشة مواده وموضوعاته واختيارها واختيار كتّاب محددين لكتابتها، كي تطل الجريدة إطلالة مثقفة بالغة الرصانة والشمول والتنوع، لكن المتجانسة في أسلوبها ووجهتها في ميادين الأدب والفلسفة والاجتماعيات والشعر والقصة: فؤاد أفرام البستاني كتب في “نظرية جديدة في الأدب الجاهلي” مناقشاً طه حسين. قسطنطين زريق طرح على نفسه سؤالا: “هل في العالم العربي اليوم فيلسوف؟” وجاوب عن السؤال هذا في مقالة. “الطبيعة والعمران في الشعر الأندلسي” عنوان يقترب من اجتماعيات الأدب لبطرس البستاني. في الميدان نفسه كتب الشاعر إلياس أبو شبكة “بين الأدب والشعر والصحافة”، وكذلك ابرهيم سليم النجار الذي بحث في “أثر الأدباء اللبنانيين والسوريين في السينما والمسرح العربيين”، فيما كتب جبرائيل جبور عن “خدمات المستشرقين للأدب العربي”. عبدالله لحود كتب مقالة تعريف بمارسيل بروست وأدبه. قيصر الجميل الذي لن يغيب اسمه عن “المكشوف” طوال عهدها إلا نادراً، كاتباً وراسم بورتريهات للأدباء، خصَّ العدد بمقالة عنوانها “هل يرى المصور في الطبيعة غير ما يراه عامة الناس؟”. في مجال الفن السابع، درة حداثة القرن العشرين، كتب كرم البستاني عن “أسرار الجمال عند غادات السينما” اللواتي وضع الفيلسوف الفرنسي إدغار موران كتاباً رائداً عنهن في الستينات عنوانه “نجوم السينما” بوصفهن صنيعة ظاهرة – “نظام” جديد يجعلهم “أنصاف آلهة” تعبدها الجماهير المعاصرة. في مقالة حنا غصن “آفة المسايرة في حياتنا الاجتماعية العامة”، تحضر إرهاصات المعالجة الأنثربولوجية في تناول العادات والتقاليد المحلية. ويشمل هذا التناول مقالة مغفلة التوقيع عن الأزياء عنوانها “بين القبعة والفستان” بوصفهما عنوان انقلاب الزي النسائي وعصريته تعبيراً عن شيوع سفور المرأة وخروجها الى الفضاء العام. هذا فيما كتب فؤاد حبيش “14 وصية منقولة عن الأديب الفرنسي موريس دير كويره، لكي تكون المرأة محبوبة”. يقول صاحب “المكشوف” إنه يعرضها “تفكهة للقراء”، كأنه انتبه الى الرصانة والثقل الثقافيين في مواد جريدته في حلتها الجديدة، فأراد التخفيف من جدِّيتها الثقيلة معتذراً لقراءها من النساء.
للمواد الصحافية حضورها الطفيف في عدد الجريدة هذا، لكنه في المقابل حضور نوعي في جدّته ودلالته وتناوله السياسة الدولية في باب مستقل عنوانه “أخبار العالم في أسبوع”، يعدّه ويحرره كامل مروة، قبل أن يصير في الأعداد التالية من نصيب لويس الحاج. الباب الصحافي الأسبوعي الآخر هو أخبار الرياضة التي يستهلها العدد بموضوع عنوانه “النهضة الرياضية في لبنان”. وهو عنوان ينبه الى أهمية العامل الاجتماعي – السياسي في نهضة الرياضة المتزامنة في المجتمع المحلي مع نهضة رياضية عارمة في أوروبا، حقبة ما بين الحربين العالميتين، التي شهدت ظهور الأحزاب الفاشية ومنظماتها الشبابية العصبوية الفائضة التنظيم والعنف، والمرتبطة بالتربية الرياضية.
ضد امارة الشعر
لا يغيب الشعر عن “المكشوف” في عددها الأدبي الاول وأعدادها اللاحقة. سعيد عقل نشر قصيدته “عشتروت” في الاول، وكذلك ميخائيل نعيمه له قصيدة عنوانها “قبور”. يتكرر حضور سعيد عقل الشعري المتقطع في الجريدة طوال سنتين او ثلاث. اما الياس ابو شبكة فهو شاعر “المكشوف” في حضور قصائده على صفحاتها، اضافة الى مساهماته النثرية والنقدية المتكررة حتى وفاته المفاجئة العام 1947. فشاعر “غلواء” و”افاعي الفردوس” كان أحد اقطاب “عصبة العشرة” منذ نشأتها في مكاتب جريدة “المعرض”، وخوضها مناظرات ومعارك ادبية على صفحاتها، قبل انتقال العصبة الى مكاتب “المكشوف” ومتابعتها المناظرات والمعارك على صفحات هذا المنبر الجديد الذي سرعان ما تصدَّر نشاط الصحافة الادبية. كانت العصبة قد وقَّعت باسمها، من دون ذكر اسماء اعضائها، المقال النقدي الادبي الافتتاحي في عدد “المكشوف” في حلتها الجديدة، وكان عنوانه “الادب العربي بين عبوديتين: عبودية التقليد القديمة وعبودية التجارة الحديثة”. المقال يشبه بياناً يستأنف سجالات العصبة حول شعر المناسبات او “التشريفات” المنبرية، على ما يسمّيه نقَّاد “المكشوف” التي سخرت، ربما بقلم ابو شبكة، بهذا النوع من الشعر الذي كان يتصدره احمد شوقي ثم بشارة الخوري (الاخطل الصغير). لم تلبث الجريدة ان لخّصت على صفحاتها “الحديث المشوِّق الذي تحدثه خليل تقي الدين في صالون شارل قرم (الشاعر الملهم) عن احمد شوقي وشاعريته العجيبة: “من نظّام الى موظف الى شاعر الى امير الشعراء”. في مناسبة وفاة شوقي كتبت “المكشوف”: “امير الشعراء يبكيه شاعران: بشارة الخوري وامين نخلة”، كأنها تومئ الى تسابق الشاعرين على حيازة اللقب او المنصب الذي شغر بوفاة متصدر “امارة الشعر العربي”. في منتصف الاربعينات خصصت “المكشوف” جائزة سنوية كبرى مقدارها الف ليرة لبنانية لأفضل مجموعة شعرية. لكن الجائزة شملت، الى الشعر، انواعاً ادبية اخرى: رواية، قصص، ودراسة عن شخصية ادبية او سياسية من لبنان، على أن ينال الجائزة في كل سنة كتاب في نوع من هذه الانواع، لتتولى “دار المكشوف” طباعة 3 آلاف نسخة من المخطوط الفائز.
خلق الله الانسان في قصة
على ان “المكشوف” كانت قد بادرت الى الاحتفال بالادب القصصي وتشجيعه وتخصيص جائزة له منذ عددها 59 في تموز 1936، وكان مقدار الجائزة 25 ليرة سورية آنذاك. لم تغب القصة عن عدد الجريدة الادبي الاول الذي نشر فيه توفيق يوسف عواد قصة عنوانها “شهوة الدم”. فعواد الى جانب خليل تقي الدين، وهما قصّاصان، من اركان محرري “المكشوف” و”عصبة العشرة”، لذا دعت الجريدة الكتّاب الى نشر قصصهم على صفحاتها للمشاركة في المباراة. تحفيزاً لهذا الفن الكتابي كتبت الجريدة في افتتاحية عددها 68 انها ترغب في أن “تفتح افقاً جديداً للأدب”.
في تحدّ لنجومية الشعر والشعراء على الارجح، وخصوصاً شعراء المناسبات والمراثي و”التشريفات”، أشارت الى ذلك الأفق في اسلوب فني اعلاني باهر: “خلق الله الانسان في (من) قصة منذ الادب المكتوب في التوراة الى يومنا هذا”، وذلك في استعارة لأسطورة آدم وحواء الإلهية. مع تأسيسها دار نشر حملت اسمها، أعلنت “المكشوف” توزيعها هدية مجانية للمشتركين فيها: نسخة من رواية “الصبي الاعرج” التي نشرتها الدار لتوفيق يوسف عواد، ثم شرعت في نشر مقالات على صفحاتها تتناول “الصبي الاعرج” والأدب القصصي. من موقّعي هذه المقالات: امين الريحاني، ميخائيل نعيمة، وميشال اسمر الذي ذيّل مقالته بإشارة الى أنه من “ندوة الاثني عشر” الناشئة بعد “عصبة العشرة”، وكان بعض من اعضائها يدورون في فلكها.
جاءت مقالة اسمر لافتة في عنوانها: “اين نحن من القصة؟ كيف تولد شخصياتها في نفس (وعي) المؤلف؟”. في اطار متابعته النشاط القصصي كتب فؤاد حداد (ابو الحن) عن عدد مجلة “العروة الوثقى” (كانت تصدرها جمعية بهذا الاسم في الجامعة الاميركية في بيروت) الخاص بـ”القصة ونهضتها في البلدان العربية”. وسرعان ما اثمر تحفيز “المكشوف” نشر القصص على صفحاتها وتخصيصها جائزة سنوية لها، فبرزت اسماء قصصية سورية، منها جورج سالم، خلدون ساطع الحصري الذي فازت قصة له منشورة باسم مستعار في “المكشوف” بالجائزة للعام 1939. وقد تألفت لجنة التحكيم من: عمر فاخوري، يوسف غصوب، الياس ابو شبكة، خليل تقي الدين، رئيف خوري، فؤاد افرام البستاني، توفيق يوسف عواد، شفيق جحا، وفؤاد حبيش. هؤلاء جميعاً وسواهم عشرات كانوا من المداومين على الكتابة في “المكشوف”. حتى مطالع الاربعينات حظي الفن القصصي بوقفات نقدية متلاحقة اكثر من كتابتها مارون عبود الذي كانت له زاوية اسبوعية ثابتة في الجريدة عنوانها “ادباؤنا”. اما الترجمات والاقتباسات القصصية عن القصة الاوروبية، وخصوصاً الفرنسية، فكان لها حضور متصل على صفحات “المكشوف”.
مذ نشرت بيان تحولها جريدة اسبوعية للأدب والادباء وصحافيّي الهوى الأدبي في ايار 1936، حتى توقفها عن الصدور مطلع الخمسينات، ظلت “المكشوف” جريدة ودار نشر، محوراً للحركة الادبية وصحافتها النشيطة والفاعلة في لبنان.
“المكشوف” مع “الندوة اللبنانية” – بدأت نشاطها في 1946، وصدر مؤسسها، مديرها ومنشّطها، ميشال اسمر، عن حلقات الحركة الادبية نفسها وصحافتها اللتين صدر عنهما كل من “المكشوف” ومؤسسها المنشّط، واستقطبت جريدته وداره للنشر معظم اعلام تلك الحركة، ادباء وكتاباً وصحافيين، واضطلعت الدار بنشر الكثير من المطبوعات الصحافية القطاعية والمهنية – شكلت محاور ثلاثة اساسية وفاعلة في الحياة الثقافية اللبنانية. فـ”المؤسسات” الثلاث تقاطعت ادوارها زمنياً وفي التعبير عن وجهة لبنانية في دوائر النشاط الادبي والصحافة الادبية والنشر، وفي دوائر انتاج ثقافة سياسية لبنانية، مستقلة ودستورية وديموقراطية في كثير من وجوهها، وتصدرتها النخب المسيحية.
تزامن نشاط “المكشوف” و”الندوة” في سنوات خمس، انتهت في مطلع الخمسينات حين توقفت “المكشوف” عن الصدور بعد رحيل او انكفاء معظم أعلامها الادبيين، وانتقال صحافييها الى العمل في صحف يومية بيروتية. أما “الندوة” فتابعت نشاطها حتى بدايات الحرب في 1975. لكن “المؤسستين” شكلتا حلقتين اساسيتين في تاريخ الحياة الثقافية والثقافة السياسية في لبنان: شغلت “المكشوف”، طوال 15 سنة، موقعاً رائداً في التأريخ غير المكتوب بعدُ للحركة الادبية اللبنانية وصحافتها. وشغلت “الندوة” دوراً اساسياً في انتاج ثقافة سياسية وادارية محورها الدولة اللبنانية المستقلة، وتمتين ركائزها وحضورها في ثقافة جماعات لبنان المتباينة، قبل ان تقوّض هذه الجماعات بحروبها الاهلية الملبننة تلك الدولة. واذا قدّر لذلك التأريخ ان يُكتب يوماً ما، فإن هاتين “المؤسستين” ستكونان من مصادره المحورية.
أعداد “المكشوف” وصفحاتها هي السجل المرجعي الوثائقي الاوسع لحلقة من تاريخ الحركة الأدبية اللبنانية غير المكتوب، لأنها المطبوعة الادبية الأطول عمراً والأكثر استقطاباً لأقلام اجيال متباينة في أعمارها، متقاربة ومتفاعلة في نشاطها وذائقتها وتجاربها، في الحقبة الأخيرة مما سمّي “عصر النهضة الادبية” البادئة في لبنان ومصر والمهجر الاميركي منذ أواسط القرن التاسع عشر. واستلهاماً لطريقة المؤرخ الفرنسي فرنان بروديل في التأريخ للحقب المتصلة والمنقطعة على الأمد الطويل، شغلت “المكشوف” حلقة انتقالية وسيطة ما بين بدايات تلك النهضة ونهاياتها، ممهدة لما سُمّي “الحداثة الثقافية” التي تصدّرها الشعر الحديث و”نجومه الرواد” في الخمسينات والستينات، وشكلت بيروت، في مجلاتها الادبية وصحافتها الثقافية ونمط حياتها الحر والمفتوح، مساحة حرة وقطباً رحباً لتلك الحداثة ونجوم شعرها حتى مطلع الثمانينات.
التعليم، المدينة، الصحافة
جمعت “المكشوف” على صفحاتها وفي منشورات دارها حشداً كبيراً من اسماء الادباء والكتّاب والصحافيين المنتمين الى اجيال متباينة. صدرت هذه الأجيال وتلك الأسماء عن نهضة التعليم الارسالي المحدث واتساع قاعدته الاجتماعية ابتداء من منتصف القرن التاسع عشر. فشمل التعليم، الى ابناء عائلات قدامى الاقطاعيين والوجهاء والتجار والمهنيين الجدد، ابناء فئات عاميّة واسعة في جبل لبنان وبيروت، ومن المسيحيين خصوصاً، وسواهم من الوافدين الى بيروت من بلدان المشرق ما بعد الحرب العالمية الاولى.
النهضة التعليمية هذه كانت رافعتها الاساسية مدارس الارساليات وجامعتاها المتنافستان في بيروت: القديس يوسف للمرسلين اليسوعيين الكاثوليك، والجامعة الاميركية للمرسلين الانجيليين البروتستانت. وقد تزامنت نهضة التعليم وشمولها اجيالاً متعاقبة، مع نشوء الصحافة وازدهارها في بيروت وحواضر جبل لبنان منذ عشايا الحرب العالمية الاولى، قبل ان تشهد توسعاً نوعياً في بيروت غداة تلك الحرب. فبيروت عاشت منذ ما قبل منتصف القرن التاسع عشر، اكثر من نهضة مدينية وسّعت رقعة عمرانها وأخرجته من انكفائه داخل اسوارها القديمة. وفي كتيب عنوانه “الخروج من البوابات الثماني الى عمران المدينة” – نُشر مرفقاً بالعدد الأول من مجلة جديدة صدرت في مطلع تشرين الثاني 2012، عن “شركة اعمار وسط بيروت” (سوليدير) باسم “البوابة التاسعة” – وصف وضاح شرارة حلقات ذلك الخروج المتدرج:
“كان عدد سكان بيروت “يناهز المئة الف نسمة في اوائل القرن العشرين، بعدما كان 60 الفا في 1836”. قفزات تزايد سكان المدينة كانت سريعة ومضاعفة ايضاً منذ مطالع القرن التاسع عشر. ويشدد الكاتب في هذه الزيادة السكانية الكبيرة على “ثقل الروافد الجبلية”، اي المسيحية، و”الخارجية”، اي الهجرات المشرقية وتوافد الجاليات الاجنبية. من الأدلة على ذلك “حادثة طائفية أوقعت في بيروت سنة 1903 نحو 15(؟) قتيلاً في اشتباك اشقياء برأس النبع، معظمهم (؟) (أي القتلى) مسيحيون، فترك بيروت لائذا بالجبل نحو 30 الف مسيحي بيروتي”. السكن المسيحي في بيروت تزايد ايضاً بعد الحرب العالمية الاولى وقيام دولة لبنان بعاصمته الجديدة التي خالطت سكانها “روافد كثيرة، غلب عليها المصدر الجبلي”. هذا كله ادخل “في صلب الاسواق (البيروتية) تجاراً واصحاب مهن جديدة، اطباء ومعالجين ووكلاء ومقاولين وبيّاعي مفرق وموظفين اداريين ومترجمين وخبراء عمارة ورصف طرق”. كان قبل ذلك الميسورون في نواة السكن البيروتي القديم والمنكفئ، يخرجون الى “الظواهر والمزارع والضواحي والروابي” القريبة من المدينة، ويخالطون “المهاجرين من جبل لبنان ومن مدن الولايات العثمانية ومن المرافئ والحواضر الاوروبية والغربية”. تأسيساً على هجرات سابقة “التقت بشرق طريق الشام، بين الصيفي والناصرة، وبزقاق البلاط والقنطاري”، نشأت مدينة بيروت المتجددة والمختلطة، و”اقامت محل سورها وخندقها وهوية اهلها مستودعات بضاعة، ومسارح ومراقص ومقاه وشاشات (ودور سينما) ومحطات سفر”، وكذلك مطاعم ووكالات تجارية ومكاتب صحف.
كان التعليم ركنا اساسيا في نهضة بيروت الحديثة هذه وازدهارها، كما كانت نهضتها وازدهارها من عوامل تنامي التعليم وتوسعه وشموله النساء وخروجهن من كنف الحياة البيتية والعائلية الى الفضاء المديني العام. وكان صدور “المكشوف” جريدة لـ”العري” في سنتها الأولى عام 1935، علامة فاقعة ومثيرة لذلك الخروج وللتحريض عليه تحريضاً استيهامياً مترجماً ومدبلجاً عن الصحافة الأجنبية، قبل أن تصير الجريدة جريدة للأدب والادباء والكتّاب، شأن عشرات الصحف الناشئة والمتخذة مكاتب لها في وسط بيروت المديني المتجدد منذ مطلع القرن العشرين. اجتمع والتقى وتعارف في مكاتب هذه الصحف وعلى صفحاتها عشرات، وربما مئات من الكتّاب المتفاوتي الأجيال والتجارب والخبرات. في “المكشوف” وحدها التقى بعض من أدباء وأعلام النهضة الادبية في لبنان والمهجر: أمين الريحاني، ميخائيل نعيمة، عمر فاخوري، الياس ابو شبكة ومارون عبود. هؤلاء، على تفاوت أعمارهم، كانت كتاباتهم تجتمع على صفحات “المكشوف” الى جانب كتابات أجيال اصغر منهم عمراً، وتختلف عنهم في التجربة والتكوّن الثقافي: فؤاد حبيش، ميشال أسمر، لويس الحاج، فؤاد حداد، خليل تقي الدين، توفيق يوسف عواد، فؤاد أفرام البستاني وسواه من البساتنة الكتّاب. معظم هؤلاء اختلطت ميولهم الأدبية بامتهان الصحافة والتعليم والترجمة، وخالطهم في “المكشوف” كتّاب من الشبان الجدد وأصحاب الميل الأدبي.
زمن اجتماعي صاعد
كان الأدب والتأدب والترجمة في أصل الرابطة العامة لمجموعات هذه الاجيال المتباينة وشللها الأدبية والصحافية التي انضوى بعضها في “عصبة العشرة” و”ندوة الإثني عشر” و”الثريا” و”أهل القلم” وسواها. وجاء تحول “المكشوف” جريدة ادبية، إمارة على توسع هذه الدوائر والروابط، وعلى تفاعل الادباء والكتّاب والصحافيين وأجيالهم المختلفة طوال 15 سنة على صفحاتها. في هذا المعنى قيل ويُقال “زمن المكشوف”، وكذلك “زمن الندوة اللبنانية” لاحقاً.
دائرة أعلام الأدب المتكونين في لبنان او المهجر، البارزين على صفحات “المكشوف” (نعيمة، الريحاني، فاخوري، أبو شبكة، عبود، ورئيف خوري)، أخذ الموت يفاجىء بعضهم واحداً تلو آخر، ابتداء من مطلع اربعينات القرن العشرين: في 22 تشرين الأول 1940 خصصت “المكشوف” عددها الـ271 لرثاء أمين الريحاني. وفي 18 آذار 1940 خصت رشيد نخلة بعدد كامل ايضاً. قبل ذلك، في 23 كانون الثاني 1936، وقفت عددها كله للكتابة عن مدرسة “الحكمة” التي تخرج منها ودرّس فيها كثيرون من كتّابها وكتّاب سواها من الصحف، فاستعاد المشاركون في كتابه العدد الخاص، أهمية “الحكمة” وأفضالها وريادتها في حركة التعليم اللبناني. في 3 آب 1946 ودّعت “المكشوف” عمر فاخوري بعدد خاص كامل تصدّرته قصيدة رثائية لالياس ابو شبكة الذي لم تلبث الجريدة نفسها ان ودعته بعدد خاص في 3 شباط 1947. ميخائيل نعيمة، وهو من جيل النهضة الأدبية الأقدم، عمَّر وتنسَّك في “شخروبه” ببسكنتا حتى مطالع الثمانينات، مستمراً على نفور من المدينة اخترق الكثير من إنتاج الأدب اللباني حتى عهد قريب. أما مارون عبود الكاتب والقاص الريفي الساخر والناقد الأدبي و”معلم الأجيال” في نهضة التعليم، فاستمر اسمه حاضراً في “المكشوف” حتى عشايا توقفها عن الصدور. رئيف خوري الناقد وصاحب “أديب في السوق” والمدرّس وواضع كتب مناهج التعليم في آداب اللغة العربية، ظل شأن عبود، حاضر القلم في الخمسينات والستينات، بعد مساهمته الدائمة في “المكشوف”.
كانت الاربعينات، إذاً، خصوصاً في نصفها الأول عهد إزهار “المكشوف”، لكنها كانت كلها وفي بعض سنواتها، محطات لرحيل أعمدة الجريدة وبدايات انصرام عهد نوع من الأدب والتأدب والأساتذة الذين كان صار كثيرون منهم مدرّسين في الجامعة اللبنانية وكلياتها الناشئة وفي دار المعلمين والمعلمات، حيث ضلعوا في تربية أجيال جديدة من المتعلمين والمثقفين بثقافة أدبية جديدة عمادها الشعر الحديث غالباً. فرفدت ثقافة هؤلاء الشبان الجدد صحافة الخمسينات والستينات والسبعينات الأدبية وغير الأدبية بطاقات جديدة. غلب على أولئك الشبان تعلمهم في الجامعة اللبنانية وتخرّجهم منها (خصوصاً كليتي التربية والآداب)، وعملهم سنوات قليلة أو كثيرة في التعليم الرسمي في بدايات انهياره في عشايا الحروب الملبننة (1975) وأثنائها. وغلب عليهم أيضاً تحدرهم “العصامي” من بيئات اجتماعية ريفية مهاجرة الى المدينة.
شجرة الأنساب السريعة هذه تشير الى خيط ما يخترق التكوّن الاجتماعي – الثقافي المتقطع والمتحوّل لأجيال متلاحقة من المتعلمين والمتثقفين ثقافة أدبية، والعاملين في مهن الكتابة والصحافة والتعليم في حقب مديدة صاعدة وواعدة اجتماعياً وثقافياً، ومنحت أجيالهم المتعاقبة معنى وقيمة في سلّم الارتقاء الاجتماعي، المادي والمعنوي والرمزي، منذ بدايات نهضة التعليم والنهضة الأدبية في منتصف القرن التاسع عشر، وطوال حوالى قرن ونصف القرن من زمن لبنان وبيروت الاجتماعي والاقتصادي والثقافي المحدث والصاعد حتى عشايا الحرب.
منعطف سوري
على عتبة الاربعينات يستوقف منعطف جديد لـ”المكشوف” على صعيد الكتابة الادبية والصحافية: تكاثر اسماء الكتّاب العرب على صفحاتها، وخصوصاً السوريين، من دون ان يغيب العراقيون والفلسطينيون. من الاسماء المتكررة: نجاتي صدقي، انور البرازي، وصفي قرنفل، نزيه الحكيم، قدري قلعجي، حيدر البرازي، انطون المقدسي، سليم الجندي، احمد عبد الجبار، سعيد الجزائري، انطوان موصلي، ميشال الصراف، اديب الداودي، زهير الحمزاوي، وفايز صايغ. بعض هؤلاء كتب – الى جانب متابعاته النشاط الادبي في المدن السورية، والعراقية احياناً – في باب شرّعته “المكشوف” واسعاً ودائماً عنوانه “السرقات الادبية” الذي أرادته مثيراً وجاذباً لمناظرات ومعارك ادبية، لتوسيع دوائر قرائها في لبنان والعواصم العربية، وخصوصاً في المدن السورية، دمشق وحمص وحلب. يبرز في هذا الاطار شقاق ادبي ما بين الكتاب اللبنانيين والسوريين من جهة، والكتاب المصريين من جهة اخرى. في هذا السياق كان الياس ابو شبكة قد كتب في العام 1939 مقالة طويلة عنوانها “ابطال الحركة الاوروبية في لبنان وسوريا”. ثم لم تلبث “المكشوف” ان اصدرت في 27 آذار من العام نفسه، “عدداً خاصاً ممتازاً عن مظاهر الثقافة في سوريا” شاركت فيه كوكبة من الكتاب السوريين. لكن الجريدة سرعان ما بادرت في 10 تموز 1939 ايضاً، الى اصدار عدد مماثل “عن مظاهر الثقافة في مصر” شارك فيه كتاب مصريون.
التأريخ الغائب لبيروت

مذ نشرت بيان تحولها جريدة اسبوعية للأدب والادباء وصحافيّي الهوى الأدبي في ايار 1936، حتى توقفها عن الصدور مطلع الخمسينات، ظلت “المكشوف” جريدة ودار نشر، محوراً للحركة الادبية وصحافتها النشيطة والفاعلة في لبنان.
“المكشوف” مع “الندوة اللبنانية” – بدأت نشاطها في 1946، وصدر مؤسسها، مديرها ومنشّطها، ميشال اسمر، عن حلقات الحركة الادبية نفسها وصحافتها اللتين صدر عنهما كل من “المكشوف” ومؤسسها المنشّط، واستقطبت جريدته وداره للنشر معظم اعلام تلك الحركة، ادباء وكتاباً وصحافيين، واضطلعت الدار بنشر الكثير من المطبوعات الصحافية القطاعية والمهنية – شكلت محاور ثلاثة اساسية وفاعلة في الحياة الثقافية اللبنانية. فـ”المؤسسات” الثلاث تقاطعت ادوارها زمنياً وفي التعبير عن وجهة لبنانية في دوائر النشاط الادبي والصحافة الادبية والنشر، وفي دوائر انتاج ثقافة سياسية لبنانية، مستقلة ودستورية وديموقراطية في كثير من وجوهها، وتصدرتها النخب المسيحية.
تزامن نشاط “المكشوف” و”الندوة” في سنوات خمس، انتهت في مطلع الخمسينات حين توقفت “المكشوف” عن الصدور بعد رحيل او انكفاء معظم أعلامها الادبيين، وانتقال صحافييها الى العمل في صحف يومية بيروتية. أما “الندوة” فتابعت نشاطها حتى بدايات الحرب في 1975. لكن “المؤسستين” شكلتا حلقتين اساسيتين في تاريخ الحياة الثقافية والثقافة السياسية في لبنان: شغلت “المكشوف”، طوال 15 سنة، موقعاً رائداً في التأريخ غير المكتوب بعدُ للحركة الادبية اللبنانية وصحافتها. وشغلت “الندوة” دوراً اساسياً في انتاج ثقافة سياسية وادارية محورها الدولة اللبنانية المستقلة، وتمتين ركائزها وحضورها في ثقافة جماعات لبنان المتباينة، قبل ان تقوّض هذه الجماعات بحروبها الاهلية الملبننة تلك الدولة. واذا قدّر لذلك التأريخ ان يُكتب يوماً ما، فإن هاتين “المؤسستين” ستكونان من مصادره المحورية.
أعداد “المكشوف” وصفحاتها هي السجل المرجعي الوثائقي الاوسع لحلقة من تاريخ الحركة الأدبية اللبنانية غير المكتوب، لأنها المطبوعة الادبية الأطول عمراً والأكثر استقطاباً لأقلام اجيال متباينة في أعمارها، متقاربة ومتفاعلة في نشاطها وذائقتها وتجاربها، في الحقبة الأخيرة مما سمّي “عصر النهضة الادبية” البادئة في لبنان ومصر والمهجر الاميركي منذ أواسط القرن التاسع عشر. واستلهاماً لطريقة المؤرخ الفرنسي فرنان بروديل في التأريخ للحقب المتصلة والمنقطعة على الأمد الطويل، شغلت “المكشوف” حلقة انتقالية وسيطة ما بين بدايات تلك النهضة ونهاياتها، ممهدة لما سُمّي “الحداثة الثقافية” التي تصدّرها الشعر الحديث و”نجومه الرواد” في الخمسينات والستينات، وشكلت بيروت، في مجلاتها الادبية وصحافتها الثقافية ونمط حياتها الحر والمفتوح، مساحة حرة وقطباً رحباً لتلك الحداثة ونجوم شعرها حتى مطلع الثمانينات.
التعليم، المدينة، الصحافة
جمعت “المكشوف” على صفحاتها وفي منشورات دارها حشداً كبيراً من اسماء الادباء والكتّاب والصحافيين المنتمين الى اجيال متباينة. صدرت هذه الأجيال وتلك الأسماء عن نهضة التعليم الارسالي المحدث واتساع قاعدته الاجتماعية ابتداء من منتصف القرن التاسع عشر. فشمل التعليم، الى ابناء عائلات قدامى الاقطاعيين والوجهاء والتجار والمهنيين الجدد، ابناء فئات عاميّة واسعة في جبل لبنان وبيروت، ومن المسيحيين خصوصاً، وسواهم من الوافدين الى بيروت من بلدان المشرق ما بعد الحرب العالمية الاولى.
النهضة التعليمية هذه كانت رافعتها الاساسية مدارس الارساليات وجامعتاها المتنافستان في بيروت: القديس يوسف للمرسلين اليسوعيين الكاثوليك، والجامعة الاميركية للمرسلين الانجيليين البروتستانت. وقد تزامنت نهضة التعليم وشمولها اجيالاً متعاقبة، مع نشوء الصحافة وازدهارها في بيروت وحواضر جبل لبنان منذ عشايا الحرب العالمية الاولى، قبل ان تشهد توسعاً نوعياً في بيروت غداة تلك الحرب. فبيروت عاشت منذ ما قبل منتصف القرن التاسع عشر، اكثر من نهضة مدينية وسّعت رقعة عمرانها وأخرجته من انكفائه داخل اسوارها القديمة. وفي كتيب عنوانه “الخروج من البوابات الثماني الى عمران المدينة” – نُشر مرفقاً بالعدد الأول من مجلة جديدة صدرت في مطلع تشرين الثاني 2012، عن “شركة اعمار وسط بيروت” (سوليدير) باسم “البوابة التاسعة” – وصف وضاح شرارة حلقات ذلك الخروج المتدرج:
“كان عدد سكان بيروت “يناهز المئة الف نسمة في اوائل القرن العشرين، بعدما كان 60 الفا في 1836”. قفزات تزايد سكان المدينة كانت سريعة ومضاعفة ايضاً منذ مطالع القرن التاسع عشر. ويشدد الكاتب في هذه الزيادة السكانية الكبيرة على “ثقل الروافد الجبلية”، اي المسيحية، و”الخارجية”، اي الهجرات المشرقية وتوافد الجاليات الاجنبية. من الأدلة على ذلك “حادثة طائفية أوقعت في بيروت سنة 1903 نحو 15(؟) قتيلاً في اشتباك اشقياء برأس النبع، معظمهم (؟) (أي القتلى) مسيحيون، فترك بيروت لائذا بالجبل نحو 30 الف مسيحي بيروتي”. السكن المسيحي في بيروت تزايد ايضاً بعد الحرب العالمية الاولى وقيام دولة لبنان بعاصمته الجديدة التي خالطت سكانها “روافد كثيرة، غلب عليها المصدر الجبلي”. هذا كله ادخل “في صلب الاسواق (البيروتية) تجاراً واصحاب مهن جديدة، اطباء ومعالجين ووكلاء ومقاولين وبيّاعي مفرق وموظفين اداريين ومترجمين وخبراء عمارة ورصف طرق”. كان قبل ذلك الميسورون في نواة السكن البيروتي القديم والمنكفئ، يخرجون الى “الظواهر والمزارع والضواحي والروابي” القريبة من المدينة، ويخالطون “المهاجرين من جبل لبنان ومن مدن الولايات العثمانية ومن المرافئ والحواضر الاوروبية والغربية”. تأسيساً على هجرات سابقة “التقت بشرق طريق الشام، بين الصيفي والناصرة، وبزقاق البلاط والقنطاري”، نشأت مدينة بيروت المتجددة والمختلطة، و”اقامت محل سورها وخندقها وهوية اهلها مستودعات بضاعة، ومسارح ومراقص ومقاه وشاشات (ودور سينما) ومحطات سفر”، وكذلك مطاعم ووكالات تجارية ومكاتب صحف.
كان التعليم ركنا اساسيا في نهضة بيروت الحديثة هذه وازدهارها، كما كانت نهضتها وازدهارها من عوامل تنامي التعليم وتوسعه وشموله النساء وخروجهن من كنف الحياة البيتية والعائلية الى الفضاء المديني العام. وكان صدور “المكشوف” جريدة لـ”العري” في سنتها الأولى عام 1935، علامة فاقعة ومثيرة لذلك الخروج وللتحريض عليه تحريضاً استيهامياً مترجماً ومدبلجاً عن الصحافة الأجنبية، قبل أن تصير الجريدة جريدة للأدب والادباء والكتّاب، شأن عشرات الصحف الناشئة والمتخذة مكاتب لها في وسط بيروت المديني المتجدد منذ مطلع القرن العشرين. اجتمع والتقى وتعارف في مكاتب هذه الصحف وعلى صفحاتها عشرات، وربما مئات من الكتّاب المتفاوتي الأجيال والتجارب والخبرات. في “المكشوف” وحدها التقى بعض من أدباء وأعلام النهضة الادبية في لبنان والمهجر: أمين الريحاني، ميخائيل نعيمة، عمر فاخوري، الياس ابو شبكة ومارون عبود. هؤلاء، على تفاوت أعمارهم، كانت كتاباتهم تجتمع على صفحات “المكشوف” الى جانب كتابات أجيال اصغر منهم عمراً، وتختلف عنهم في التجربة والتكوّن الثقافي: فؤاد حبيش، ميشال أسمر، لويس الحاج، فؤاد حداد، خليل تقي الدين، توفيق يوسف عواد، فؤاد أفرام البستاني وسواه من البساتنة الكتّاب. معظم هؤلاء اختلطت ميولهم الأدبية بامتهان الصحافة والتعليم والترجمة، وخالطهم في “المكشوف” كتّاب من الشبان الجدد وأصحاب الميل الأدبي.
زمن اجتماعي صاعد
كان الأدب والتأدب والترجمة في أصل الرابطة العامة لمجموعات هذه الاجيال المتباينة وشللها الأدبية والصحافية التي انضوى بعضها في “عصبة العشرة” و”ندوة الإثني عشر” و”الثريا” و”أهل القلم” وسواها. وجاء تحول “المكشوف” جريدة ادبية، إمارة على توسع هذه الدوائر والروابط، وعلى تفاعل الادباء والكتّاب والصحافيين وأجيالهم المختلفة طوال 15 سنة على صفحاتها. في هذا المعنى قيل ويُقال “زمن المكشوف”، وكذلك “زمن الندوة اللبنانية” لاحقاً.
دائرة أعلام الأدب المتكونين في لبنان او المهجر، البارزين على صفحات “المكشوف” (نعيمة، الريحاني، فاخوري، أبو شبكة، عبود، ورئيف خوري)، أخذ الموت يفاجىء بعضهم واحداً تلو آخر، ابتداء من مطلع اربعينات القرن العشرين: في 22 تشرين الأول 1940 خصصت “المكشوف” عددها الـ271 لرثاء أمين الريحاني. وفي 18 آذار 1940 خصت رشيد نخلة بعدد كامل ايضاً. قبل ذلك، في 23 كانون الثاني 1936، وقفت عددها كله للكتابة عن مدرسة “الحكمة” التي تخرج منها ودرّس فيها كثيرون من كتّابها وكتّاب سواها من الصحف، فاستعاد المشاركون في كتابه العدد الخاص، أهمية “الحكمة” وأفضالها وريادتها في حركة التعليم اللبناني. في 3 آب 1946 ودّعت “المكشوف” عمر فاخوري بعدد خاص كامل تصدّرته قصيدة رثائية لالياس ابو شبكة الذي لم تلبث الجريدة نفسها ان ودعته بعدد خاص في 3 شباط 1947. ميخائيل نعيمة، وهو من جيل النهضة الأدبية الأقدم، عمَّر وتنسَّك في “شخروبه” ببسكنتا حتى مطالع الثمانينات، مستمراً على نفور من المدينة اخترق الكثير من إنتاج الأدب اللباني حتى عهد قريب. أما مارون عبود الكاتب والقاص الريفي الساخر والناقد الأدبي و”معلم الأجيال” في نهضة التعليم، فاستمر اسمه حاضراً في “المكشوف” حتى عشايا توقفها عن الصدور. رئيف خوري الناقد وصاحب “أديب في السوق” والمدرّس وواضع كتب مناهج التعليم في آداب اللغة العربية، ظل شأن عبود، حاضر القلم في الخمسينات والستينات، بعد مساهمته الدائمة في “المكشوف”.
كانت الاربعينات، إذاً، خصوصاً في نصفها الأول عهد إزهار “المكشوف”، لكنها كانت كلها وفي بعض سنواتها، محطات لرحيل أعمدة الجريدة وبدايات انصرام عهد نوع من الأدب والتأدب والأساتذة الذين كان صار كثيرون منهم مدرّسين في الجامعة اللبنانية وكلياتها الناشئة وفي دار المعلمين والمعلمات، حيث ضلعوا في تربية أجيال جديدة من المتعلمين والمثقفين بثقافة أدبية جديدة عمادها الشعر الحديث غالباً. فرفدت ثقافة هؤلاء الشبان الجدد صحافة الخمسينات والستينات والسبعينات الأدبية وغير الأدبية بطاقات جديدة. غلب على أولئك الشبان تعلمهم في الجامعة اللبنانية وتخرّجهم منها (خصوصاً كليتي التربية والآداب)، وعملهم سنوات قليلة أو كثيرة في التعليم الرسمي في بدايات انهياره في عشايا الحروب الملبننة (1975) وأثنائها. وغلب عليهم أيضاً تحدرهم “العصامي” من بيئات اجتماعية ريفية مهاجرة الى المدينة.
شجرة الأنساب السريعة هذه تشير الى خيط ما يخترق التكوّن الاجتماعي – الثقافي المتقطع والمتحوّل لأجيال متلاحقة من المتعلمين والمتثقفين ثقافة أدبية، والعاملين في مهن الكتابة والصحافة والتعليم في حقب مديدة صاعدة وواعدة اجتماعياً وثقافياً، ومنحت أجيالهم المتعاقبة معنى وقيمة في سلّم الارتقاء الاجتماعي، المادي والمعنوي والرمزي، منذ بدايات نهضة التعليم والنهضة الأدبية في منتصف القرن التاسع عشر، وطوال حوالى قرن ونصف القرن من زمن لبنان وبيروت الاجتماعي والاقتصادي والثقافي المحدث والصاعد حتى عشايا الحرب.
جذر النهضة: لغوي – أدبي؟

في سياق التأريخ السريع لمحطات من الحياة الأدبية وصحافتها وأعلامها على المدى الطويل، يستوقف عدد خاص نشرته “المكشوف” في 15 شباط 1946، لمناسبة مرور 75 سنة على وفاة الشيخ ناصيف اليازجي، وإحياء لذكراه بصفته أحد الأعلام الثلاثة المؤسسين للنهضة الأدبية واللغوية في لبنان. هل النهضة هذه أدبية ولغوية في جذرها؟ أعلامها في جيلها الأول هم: الشيخ ناصيف اليازجي، نقولا الترك، وبطرس كرامة. ويلحق بهم ويزامنهم لبعض الوقت في سياق آخر المعلم بطرس البستاني.
ساهم في الكتابة عن اليازجي في عدد “المكشوف” الخاص به: مارون عبود، بطرس البستاني (هو غير المعلم بطرس طبعاً)، إلياس ابو شبكة، فؤاد افرام البستاني، يوسف اسعد داغر وصلاح الدين علام. هؤلاء جميعاً وسواهم برغم تفاوت أعمارهم هم من الأجيال الأخيرة للنهضة الأدبية، وساهموا في إطلاق “المكشوف” في 1936 (لكن صلاح الدين علام قد يكون أحد اسمين مستعارين – الآخر زهير زهير – استعملتهما “المكشوف” استعمالاً دائماً وكثيفاً لكتابة مقالات سجالية متعلقة بالفكرة اللبنانية وبالانقسامات الساخنة الدائرة حولها. والاستعارة هذه تطرح سؤالاً حول معنى هذا التخفّي ودلالته حين تصدي الجريدة لسجالات اساسية لا يخفى بعدها السياسي والطائفي).
مقدمة العدد المغفلة التوقيع، تشير الى ان دور اليازجي في النهضة كان “التبحّر في أسرار اللغة العربية، تبسيطها وتطويعها للأفهام وتحبيبها الى القلوب، ونشرها بين الجماهير” (غريب استعمال كلمة “الجماهير” في هذا السياق، قبل ولادة الزمن الجماهيري وطغيانه بدءاً من الخمسينات). أما “أبناء اليازجي وبناته (فانصرفوا) إلى مثل عمله انصراف العشرات من العيال (العائلات) اللبنانية: التحقيق والدرس والنشر والتعليم”. لكن مارون عبود في مقالته عن اليازجي، يخالف هذه الوجهة النهضوية وينقضها: “كان شيخنا يستوحي الكتب القديمة، لا يستلهم غيرها في كل ما نظم وكتب. فكأني به ذات مجردة من المكان والزمان، فما علق بشعره شيء منهما”. إنه ذات لغوية محضة أو خالصة إذاً. وهذا يؤكد الجذر اللغوي للنهضة. وبأسلوبه النقدي الثاقب والساخر، يتابع عبود: “من لا يعرف انه (اليازجي) نشأ في كفرشيما وشبّ واكتهل في بتدين (بيت الدين، بديوان قصر الأمير بشير الثاني) وشاخ في بيروت، خاله من مواليد نجد واليمن”، حيث المصدر البعيد للغة العرب. وتبلغ سخرية عبود ذروتها، فيكتب أن اليازجي وضع “مقامة في مجمع البحرين سمّاها “المقامة اللبنانية” (لكن) ليس فيها شيء من ريحة (رائحة) لبنان. فالمتنبي الذي مرَّ عَرَضاً من وراء لبنان وشاهد قفاه أو قممه من حمص، تأثر به أكثر من شيخنا” المساهم في تأسيس النهضة.
بطرس البستاني (غير المعلم) يشير في مقالته عن اليازجي إلى “خدمته الفصحى وأبناءها” (اللغة أيضاً وأيضا)، ثم إلى عمله في ديوان الأمير بشير: “قاعة العمود (حيث كانت تنعقد) حلقات (أميرية) للسياسة والتدبير وللكتّاب والشعراء يرتفع فيها صوت نقولا الترك وبطرس كرامة. أما رئيف خوري فكتب عن “يقظة الوعي العربي في مقامات اليازجي”: اليقظة والوعي هذان ماذا يكونان في المقامات سوى لغويين؟ هذا ما يؤكده الياس أبو شبكة حين يذكر، في سياق مقالته عن اليازجي، أن المعلم بطرس البستاني المولود سنة 1844، مجدّدٌ لغوي بامتياز. فهو “صاحب قاموس “محيط المحيط” و”دائرة المعارف”، وأول من أنشأ جريدة عربية حرة في هذه الديار”. الجريدة هي “الجنان” التي أصدرها البستاني سنة وفاة اليازجي (1871)، و”عهد تحريرها لابنه سليم البستاني، فنشرت ترجمة لليازجي بقلم الأديب سليم أفندي دياب”. “المكشوف”، بدورها نقلت هذه الترجمة عن “الجنان” وأثبتتها في عددها الخاص عن عَلَم النهضة ناصيف اليازجي. وهي، بعد مرور حوالى مئة سنة على بدايات النهضة، وعودتها من سنة ضلالها “رسولاً (صحافياً مترجماً) للعري”، لم تكن نهضتها شيئاً آخر غير نهضة أدبية – لغوية، تشهد على ذلك عودتها الى “جادة الصواب الأدبي”، مجدّدة في تناول الموضوعات الأدبية وفي لغة الصحافة، ومساجلة في شؤون الأدب والأدباء والشعراء وفي ما يتصل بذلك من قضايا واهتمامات.
طوّرت طوال عهدها وجوهاً كثيرة من العمل الصحافي، فتابعت قضايا وقطاعات ونشاطات في الحياة الاجتماعية والفنية (السينما خصوصاً)، وخصصت زوايا لموضوعات إدارية ومعيشية، ولشؤون السياسة الدولية، لكن هذا لا يقاس بمادتها الأدبية الطاغية. الأدب هنا هو الكتابة الأدبية التي تتناول موضوعات أدبية وتطلق سجالات مدارها الأدب وحرفة الأدب التي تبحر غالباً وتتبحر في ما يسمّى “العصور الأدبية الكلاسيكية” أو الأقرب عهداً. التبحر في تلك العصور، ما هي مادته؟ اللغة طبعاً (ألهذا شاعت في أدبيات الحداثة الشعرية المتأخرة زمناً عبارات مثل: تفجير اللغة؟).
الى هذا التبحر في مدارات الأدب واللغة الأدبية، هنالك الترحال في بعض لإنتاجات الأدب العالمي، قصة وشعراً ومقالات صحافية، اقتباساً وترجمة وتلخيصاً. أما الغائب الأكبر عن مدارات الأدب هذه، فهو العالم المادي الحسي، هنا والآن، وهناك في الأمس البعيد والقريب. وحين يجري تناول هذا العالم الدنيوي، غالباً ما تنتصب دونه غشاوات الإنشاء الأدبي. تغيب عن “المكشوف” (وغالباً عن صحافتنا اليوم) الكتابة الميدانية الحيّة التي تصف وقائع الحياة المادية والاجتماعية الزائلة، ظواهرها، حوادثها، تحولاتها، سياقاتها. أي الكتابة التي تؤرخ وتطلق الوعي والمخيلة في النظر الى الوقائع، بعيداً من الانشاء الأدبي اللغوي. الأرجح أن العوامل المؤسسة لهذا الغياب والباعثة عليه كثيرة متدافعة، ومتعلقة بطبيعة الثقافة واللغة العربيتين النهضويتين، وبطبيعة تكوّن الكتّاب والصحافيين تكوّناً أدبياً ومتأدباً، كأن النهضة إحياء لغوي في جذرها الأساس. والحق أن معظم كتاب “المكشوف” يمتلك لغة أدبية متميزة في الكتابة التي تنأى من حيوية الوقائع الحسية وسيولتها. كانت الحياة في “زمن المكشوف” قوية النبض والحوادث والتحولات طوال 15 سنة في المدينة وفي أرجاء لبنان، لكن هذا لم يحضر على صفحات الجريدة إلا أدبياً وفي لغة أدبية. ولعل أمين الريحاني وعمر فاخوري ومارون عبود يخالفون هذا المذهب في الكتابة. فـ”فيلسوف الفريكة” ليس فيلسوفاً في الحقيقة، بل أقرب الى رحالة يشاهد ويشهد ويؤرخ مشاهداته. أما فاخوري وعبود، وكذلك رئيف خوري وتوفيق يوسف عواد، فيتركون جانباً من أثقال لغة الأدب الانشائية وتراثها، فيما هم يكتبون متابعاتهم النقدية.
حداثة الفردية المختنقة
اعترض الروائي التشيكي والفرنسي لاحقاً، على التشوهات التي أدخلها مترجم روايته “المزحة” من التشيكية الى الفرنسية. يقول كونديرا إنه كتب في روايته: السماء التشرينية زرقاء. المترجم الفرنسي كتب: السماء التشرينية ترفع رايتها الباذخة. وكتب كونديرا: استولى عليّ الحزن، أما المترجم فكتب: عَلِقتُ في أنشطوطة حزن عظيم. وحين كتب الروائي: النساء عاريات، كتب المترجم: النساء يرتدين لباس حواء. هذه التشوهات وأمثالها الكثير حاضرة حضوراً طاغياً في أساليبنا الكتابية العربية حتى اليوم ومنذ ما قبل “المكشوف” التي تناول أحدهم فيها الجنرال ديغول، فكتب إن علينا أن “نحيّي فيه المِلح الخالدة”. آخر وصف الكاتب الاميركي مارك توين بـ”الفَكِهْ”. ثالث أكثر من استعمال كلمات “الطرفة”، “الطُرف”، فيما هو يكتب عن أشعار عزرا باوند. رابع وصف جنازة عمر فاخوري، فكتب: “كان نفر قليل يتناهد الى النعش”. خامس يخاطب اللبنانيين كاتباً – قائلاً: “الحلم الذي هدهد المهدَ لآبائكم مئات السنين”، و”الأمنية التي زغردتها فتاة زغرتا لفتى الأرز”، قاصداً الاستقلال بهذين الحلم والأمنية.
لكن عمر فاخوري كتب وهو على فراش المرض قبيل أيام من رحيله: “تُرى هل نقضي العمر في التفلسف على الحياة من دون أن نحيا؟”. وكتب ايضاً: “نحن لا تاريخ لنا لأنه لا حياة. لكننا نؤرخ. نؤرخ اليأس”.
قبل فاخوري، غداة صدور كتاب ميشال أسمر “مذكرات ميشال زكور” عن “دار المكشوف” عام 1938، علّق فؤاد حداد (أبو الحن) على الكتاب، فاعتبر أنه مذكرات جيله وجيل أسمر، المولود في الحرب العالمية الأولى. وكتب حداد أن “الأدب” الذي يكتبه ذلك الجيل الطالع في لبنان، هو “أدب الأنانية” (الأرجح أن الكاتب – المعلق كان يقصد بالأنانية الذاتية أو الفردية). وها هوذا يشرح معنى ذلك “الأدب الأناني” فيكتب أنه يعبّر عن: “الضعف المستتر بالقوة، الطهارة المغلّفة بالشهوات، الحياة الراكدة تحت هيجان المخيلة وغربة الإحساس، فيض الحب المهدور، الإيمان المبطن بالكفر، المجهول الشخصية (أي الغفل)، برغم تعدّد الشخصيات”.
خلف هذه الثنائيات التي لا يزال الأدب اللبناني الأحدث، شعراً ونثراً، يعتبرها قدس أقداس لاهوته التعبيري، يكمن الاختناق الجديد، الفردي والذاتي، بالفردية المقلقة أو الموقوفة. من الاختناق هذا يصدر معظم اللاهوت – الجهاز التعبيري والفني الذي به تجاوزت الكتابة اللبنانية الحديثة الانشاء اللغوي للنهضة. ميشال أسمر يعبّر صادقاً في مذكراته عن اختناقه بتلك الفردية الأسيرة غير القابلة للاحتمال: “آه منك يا نفسي! الى أين يقودني اهتمامي بكل نفثة من نفثاتك ونغمة من نغماتك؟ أنا مثقل بكِ، متعب بنضجك”.
لماذا مُتعِبٌ هو النضج؟! هل لا خلاص من هذه الحال إلا ببراءة الطفولة أو بالنبوة الجبرانية أو بالموت؟